لماذا
ارتأى المجلس هذا المقترح في هذا الوقت بالذات؟ هل استنفدت الدولة جميع الحلول
لتنويع مصادر تمويل المدرسة العمومية حتى تعرب مرة أخرى من خلال المجلس عن رغبتها في
صلب جيوب الطبقات المتوسطة بإجبارهم على أداء رسوم التسجيل، أم هي التحولات
العالمية لسوق الشغل و عولمة التخصصات الجامعية التي تفرض علينا هذا الواقع
الجديد؟ قد يعتقد بعض أعضاء المجلس أن سن ضرائب للنهوض بالقطاع، و إحداث رسوم
تسجيل باعتبارها واجباً إلزاميا على الطبقات الاجتماعية الوسطى مع إعفاء الأسر
المعوزة، حل يتماشى مع موضة العصر، خصوصا وأن أعددا هائلة من الأسر المغربية الآن ترسل
أبناءها إلى مدارس حرة، وتؤدي رسوم تسجيل باهظة الثمن مقابل الخدمات التي تقدمها
هذه المؤسسات، إذن، أين هو العيب في تحويل جزء بسيط من هذه المبالغ لفائدة المدرسة
العمومية، والرفع من جودتها، و بهذا قد نحقق تضامنا وطنيا بالإسهام في إنقاد
المدرسة العمومية؟ ربما هكذا خمن حُصفاء وخبراء هذا المجلس الموقر!؟
هل استورد
المجلس مبدأ التكافل الاجتماعي و فكرة تقاسم التكاليف (cost sharing)
من ممارسات المنظومة التربوية في الدول الغربية الرائدة في هذا المجال؟ و إذا كان
الجواب بنعم، أليس من الحكامة الجيدة أن نقوم بدراسات ميدانية حول مدى قابلية هذا
المبدأ للتطبيق في دولة الاستقبال تفاديا لأي ضرر محتمل على الاقتصاد الوطني،
فربما يؤدي هذا الإجراء إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطن؟ كيف يمكن توطين هذا
المبدأ وأقلمته في ثقافة تؤمن بمجانية التعليم منذ الاستقلال، و تعتبره حقاً
دستوريا مهما كانت العائدات الشهرية للعوائل؟ لماذا هرولت نخبنا لهذا الاكتشاف
البالي الذي استهلكه الغرب منذ زمن، و بدأت تطبل و تزمر له كحل سحري دون دراسة
استباقية لمدى قابلية أقلمته في الواقع المحلي بمختلف خصوصياته؟ هل يكمن
مشكل المدرسة العمومية في تنويع موارد التمويل؟ هل بأداء الرسوم المدرسية
ستتبخر مشاكلنا التعليمية؟ أنظر إلى الدول الأوروبية التي طبقت مبدأ تقاسم
التكاليف في المستوى الجامعي، كفرنسا مثلا، كيف تساهم في إعانة
الأسر متوسطة الدخل عند بداية كل موسم دراسي في المستويات الأدنى قصد شراء الكتب و
أداء واجبات التسجيل، و الأمر هنا لا يتعلق بالأسر المعوزة فقط؟
قبل أن نتطرق
لمطبات أجرأة هذا المقترح، و التأمل في بعض الحلول البديلة، نود أن نسلط الضوء في
البداية على الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها المدرسة العمومية، ونخص
بالذكر هنا قطاع التعليم العالي و ما يطرحه من قضايا شائكة آنية و مستقبلية في
إطار عدم ملاءمته لسوق الشغل. إن الوجه الخفي لمقترحات المجلس الأعلى للتربية
والتكوين يتضح في اعتراف المجلس الضمني والصريح بتراجع المنظومة التعليمية و
تعثرها بشكل جلي في سوق الشغل، حيث يوجد الآن إجماع وطني حول هذه النقطة بالذات، و
تؤكد التقارير الرسمية والصحفية على فشل المنظومة التعليمية في تصدير كفايات و
مهارات تحتاجها سوق الشغل لإدماجها في العمل.
هذا طبعا لا
يفاجئنا لأن المنظومة التعليمية التي أُسست منذ عهد الاستقلال، اهتمت بتكوين النخب
لولوج الإدارات العمومية، وليس للالتحاق بسوق رأسمالية تستند إلى الخبرة
التكنولوجية والمعلوماتية. الكل يعلم أن التعليم الجامعي تمحور حول القضايا
الاجتماعية و الدينية والثقافية والسياسية والتاريخية و الجغرافية التي تهم هذا
البلد، و لم يهتم كثيراً بالعلوم التطبيقية والابتكارات التكنولوجية إلا في ميادين
جد محدودة. لقد كان و لا يزال تعليما اجتماعيا بامتياز، يستمد قوته من العلوم الإنسانية
لتحريك عجلة الإدارات العمومية والاقتصاد عموما. لفائدة هذا التعليم يشهد التاريخ
بأنه أدى الرسالة المجتمعية، و أنجب كوادر أكفاء في تخصصات شتى، كما يشهد له
التاريخ بأنه لم يتخل قط عن رسالته التوعوية، أو حدث أن انسلخ عن قضايا
مجتمعه.
هذه المنظومة
التعليمية اليوم تقف في قفص الاتهام، و تُتهم بتشريد الناشئة في الشوارع، و تسويق
بضاعة فاسدة منتهية الصلاحية في سوق الشغل، حيث الطلب الآن ينصب على تكوين أطر
تقنية خدماتية تواكب التطور التكنولوجي والمعلوماتي، وليس على تخصصات أكاديمية
نظرية ذات أبعاد مفاهيمية إبستمولوجية. وهكذا أصبح مصير التعليم مرتبطا بقدرته
التنافسية على خلق و ابتكار تخصصات تطبيقية تستجيب لطموحات المشاريع الاستثمارية
في القطاع الخاص. وأمام تراجع قدرة القطاع العام على استيعاب خرّيجي العلوم الإنسانية،
أمسى هذا التخصص الذي يساهم في بناء المنظومة القيمية للمجتمع، و يساهم في تطوير
العقول و الذهنيات على حافة الاندثار. هذه الكليات الآن تنحو مسارا قاتما، إما أن
تنفتح على تخصصات تطبيقية، و بالتالي تضحّي بالعلوم الإنسانية في بعدها الفلسفي، و
إما سيتم إغلاقها مستقبلا بسبب شواهد "الإعاقة المهنية" التي تسلمها إلى
الشباب المغاربة. إن البضاعة الوحيدة التي تستطيع هذه المؤسسات إنتاجها اليوم هي
الشواهد الجامعية المعترف بها إداريا، لكن نادرا ما تُقبل في القطاع الخاص.
حين تصبح
القوة الاقتصادية عاملا محددا لإنتاج المعرفة، ستنقرض تلك التخصصات التي
أنتجها المجتمع لأسباب اجتماعية و سياسية و ثقافية أكثر منها اقتصادية، فالآداب
و العلو م الإنسانية والاجتماعية قد لا تجد فرصا للشغل بالمقارنة مع العلوم
التطبيقية والتكنولوجية في مغرب اليوم، خصوصا إن لم تتحول إلى بضاعة قابلة
للتسويق.
أصبح أخطبوط
الرأسمالية العملاق المتمثل في الشركات متعددة الجنسيات يحتل الأسواق المحلية
اليوم، و يضع شروطه ومناهج عمله، و يخلق التخصصات التي تناسب صناعاته ونشاطاته
الاقتصادية. هنا قد يتساءل القارئ عن مآل العلوم الإنسانية والاجتماعية التي ساهمت
تاريخيا في بناء نسيج المجتمعات و أنساقها الفكرية، و عبأت الفاعلية السياسية
وجندت المجتمعات للدفاع عن حقوقها؟ فلتذهب إلى الجحيم!؟، هكذا يجيبك الأخطبوط ،
ويضيف بأنه في حاجة إلى تقنيين و خبراء و مهندسين و أطباء و علماء مهادنين مذعنين
خاضعين. ليس المهم هو تعبئة المجتمع أو تخليقه بقدر ما هذا المجتمع في حاجة إلى
الفرجة والاستهلاك. إن المسالك التي يقترحها علينا الأخطبوط العملاق، قد توفر
لناشئتنا وظيفة و أجرة، لكنها ستكتفي بمعرفة خدماتية برغماتية، تكون في غالب
الأحيان مبتورة من أنساقها الفكرية وأسسها الإبستمولوجية، تلك معارف جزئية بدون
قيم أو مبادئ أو مواقف تضامنية، و حتى درع الإيمان سيتصدع في هذا السياق من جراء
قوة الصدمة الحداثية التي نعيشها اليوم. و كل تفريط محتمل في العلوم الإنسانية
يعتبر جريمة في حق المجتمع و إهدارا للمسؤولية الأخلاقية في حقه، و لنمعن النظر
كيف أدى تراجع العلوم الإنسانية (خصوصا الفلسفة وعلم الاجتماع) في العقود الأخيرة
إلى فتح الباب أمام ولوج أفكار راديكالية متطرفة بين ثنايا مجتمعاتنا العربية.
نحن نعي
جسامة المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسات الجامعية اليوم، إذ أن الهدف هو
تحويلها من مركز لتلقين المعارف النظرية إلى محرك للاقتصاد الوطني، و هذا يتطلب
تسليع التعليم وبيع منتجاته في السوق المحلية والدولية، مما يحتم علينا إنتاج
معارف تطبيقية تساير مقاربات الشركات العملاقة. نحن نعيش اليوم اقتصادا سياسيا
للمعرفة تتحكم المقاربة الاقتصادية في بلورة مفاهيمه و طرق تعليمه. إنها
التبعية التي تفرضها عولمة الرأسمالية و المؤسسات المانحة التي تعبّد لها الطريق،
فحتى في الدول الإمبريالية، يعرف التعليم الاجتماعي تراجعا أمام التعليم
التسويقي، ففي الولايات المتحدة مثلا، يحتل التعليم الجامعي الرتبة الثالثة في
قائمة الصادرات الوطنية، و يضخ في خزينة الدولة حوالي 20 مليون دولار سنويا، مما
يمنح هذا القطاع أولوية خاصة عند رسم السياسات الكبرى، و يضمن له استمرارية
التنافس في السوق العالمية.
يبدو لنا
ظاهريا أن المجلس الأعلى للتكوين قدم مقترحا دون دراسة جوانبه الإيجابية والسلبية،
لأننا حتى لحظة كتابة هذه السطور، لم نقرأ عن الإكراهات والمشاكل التي قد يطرحها
مثل هذا الإجراء، و هل فعلا يتبنى المجلس وجهة نظر ناقدة، أم يبصر الواقع بمنظار
وردي الألوان يعتقد في سماء تمطر ذهبا وفضة بعد تبخر عرق البؤساء من أفلاذ هذا
الشعب في المثابرة لتغطية نفقات صك البقاء على قيد الحياة. هل اعتماد مبدأ تقاسم
التكاليف و إحداث تكوينات مؤدى عنها سيطرح مشاكل مستقبلا؟ و ما نوع هذه المشاكل يا
ترى؟
لقد
بدأت بالفعل إرهاصات أداء تكاليف الدراسة عن طريق إحداث تخصصات ماستر بالمقابل، و
إنشاء جامعات حرة، و هذه التكوينات و المؤسسات غالبا ما تستقطب طلبة لا يتوفرون
على معدلات تنافسية عالية بالمقارنة مع نظرائهم الذين يلتحقون بالتكوينات
والكليات المجانية. تواجه هذه التكوينات غير المجانية بالأساس عائق الجودة
بالرغم من ضخها أموالا في ميزانية المؤسسة، لأنها عادة ما تأتي على حساب تقلص
أنشطة البحث العلمي، وسؤالنا في هذا الصدد، ماذا استفادت الدولة والجامعة
المغربية بصفة عامة من ظهور جامعات حرة؟ هل ساهمت هذه الأخيرة في تطوير البحث
العلمي بالمغرب؟
أمام تزايد
الطلب على جودة التعليم، و أزمة الانفجار الديموغرافي، و تفاقم الأعداد المسجلة من
الطلبة بين التخصصات المطلوبة والتخصصات المستغنى عنها في سوق الشغل، و تكاثر
البطالة المؤهلة، دخلت الدولة في سباق محموم لانتشال منظومتها التعليمية من
وحل العطالة و انتهاء الصلاحية، فأصبحت تسطر برامج استعجالية، و هي الآن بصدد
التفكير في الحل المنتشر عالميا تحت مسمى تقاسم التكاليف، إذ تسعى إلى إجبار
العائلات على تحمل مصاريف تعليم أبنائها، وهذا في العمق فعل تضامني ، إذ ينطلق من
مبدأ التكافل بين الميسور والفقير في إطار صدقة إلزامية تفرضها الدولة في شكل رسوم
تسجيل، لكن السؤال المطروح، هو هل هذا كاف لتغطية مصاريف المؤسسات الجامعية؟ هل
هذا سيساهم في حل عجز ميزانية الدولة الموجهة إلى هذا القطاع؟ لا ننسى أنه في
دول أوروبا وأمريكا التي عملت بهذا المبدأ منذ عقود، اعتمدت تنويع مصادر تمويل
المؤسسات التعليمية عن طريق جمع التبرعات من المجتمع المدني و مؤسسات أخرى مانحة
لضمان جودة خدماتها.
علينا أن نعي
أن مبدأ تقاسم التكاليف (cost-sharing) لا يشجع
التعليم الديمقراطي، كما يظن بعض أعضاء المجلس، لأن تطبيق هذا النظام على الأسر
القادرة على المساهمة، سيطرح عدة مشاكل، نذكر منها أولا صعوبة أجرأة المعايير
المتعلقة بالأسر الملزمة بالمساهمة، ثانيا، هل ستقيم الدولة بُنى تحتية و استراتجيات
للقروض على غرار الدول المتقدمة لسد الفراغ بين من سيساهم من ماله الخاص لتغطية
تكاليف الدراسة، و من قد يلتجأ إلى القروض أو المنح الدراسية؟ هل فكرت الدولة في
التسعيرة الأدنى التي لن تضر بمصلحة الاقتصاد الوطني؟ إن تقاسم التكاليف
سيضعف حتما القوة الشرائية للطبقات الوسطى، مما قد يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني،
هذا بغض النظر عن العطالة في صفوف الخريجين و تكاثرهم في تخصصات غير مطلوبة في سوق
الشغل.
هل من الممكن
تصور سيناريوهات بديلة لتقاسم تكاليف التعليم الجامعي؟ هذا السؤال الجوهري هو الذي
دفعنا في الحقيقة إلى استكشاف تاريخ الثقافة التعليمية بالمغرب، و استنباط بعض
المعاني من طقوسها، مثل طقس " بيضة بيضة... باش نزوق لوحتي"، إذ
لا زالت الذاكرة الشعبية تختزن هذا الطقس الاحتفالي لحفظة القرآن في عدة مناطق
مغربية، حيث دأب الطلاب على جمع تبرعات و هبات عينية أو نقدية أيام العيد، أو كلما
تخرج طالب جديد، وهي عبارة عن ابتهالات يرددها طلبة القرآن، تدل على مدى كرم
مجتمعنا وتضامنه مع أهل العلم، حيث تكافئ ساكنة الدواوير الفقيه على كده في
سبيل تلقين الأطفال آيات من القرآن الحكيم، و تنشئتهم على التربية الدينية. ألا
يحق لنا اليوم أن نحيي هذا الطابع التضامني و نحافظ عليه بطريقة حداثية في تعليم
أبنائنا ؟
هكذا يبدأ
مطلع تلك الابتهالات:
أمولات
الخيمة أعطيني بيضة بيضة...
باش نزوق
لوحتي لوحتي عند الطالب
والطالب في
الجنة والجنة محلولة
حللها مولانا
مولانا مولانا لا تقطع رجانا
الطالب وأصحابو في الجنة يتصابوا...
هذا مطلع دال
جداً، إذ يحيلنا على الدرجة الرفيعة التي يحتلها الفقيه والمتعلم في الذهنية الشعبية،
فهما معا يُصنّفَان من أهل الجنة. و يعتبر هذا رأسمالا رمزيا يستند إليه طالب
العلم لبسط سلطته الثقافية على باقي المجتمع، كما يدل هذا المقطع على أن
مبدأ التضامن في تعليم الناشئة ظل بعيدا عن التسويق والتسليع والاستهلاك. لقد
ازدهر التعليم الاجتماعي بمجتمعنا، و تخللت مجالسه الولائم والإحسان و
الصدقات، فانتشرت الزوايا و المراكز الصوفية لنشر المعرفة والعلم بالمجان، وانخرطت
القبائل في دعم هذا النوع من التعليم، و كما قامت بالحرث التضامني للأرض في إطار
"التويزة"، عملت على حراثة الذهن بشكل تضامني كذلك. إذن، ما هي الدروس
التي يمكن استخلاصها من شعار "بيضة بيضة... باش نزوق لوحتي"؟
أولا، يجب
إعادة النظر في فوضى توزيع رخص قطاع التعليم الخاص، و ضمان جودته، و الحرص على أن
لا تذهب عائدات هذا التعليم فقط إلى جيوب المستثمرين دون إسهامهم في تطوير القطاع
العمومي، إذ لا يعقل أن تدر مؤسسات تعليمية حرة أرباحا طائلة على أصحابها دون أن
يساهموا في النهوض بالمدرسة العمومية سواء على مستوى التكوين أو اللوجيستيك أو
البنية التحتية. إذا كان طلبة العلم يطوفون الدواوير لجمع التبرعات، فالوضعية
الراهنة الآن تقتضي مساهمة إجبارية من المؤسسة الحرة للنهوض بالقطاع العام في إطار
تعليم تضامني.
ثانيا،
"بيضة بيضة باش نزوق لوحتي" تعتبر مقاربة تشاركية جديدة بين القطاع
العام والخاص والمجتمع المدني و الأوقاف، حيث أصبح اليوم من الضروري مساهمة
الأوقاف في تمويل القطاع العام، و هنا نتساءل عن الدور التي تقوم به الأوقاف
للنهوض بالخدمات الاجتماعية في هذا البلد، فكيف هي التي لعبت دورا تاريخيا في نشر
الرسالة العلمية عبر أنحاء المغرب، من خلال دعم الزوايا و مدارس التصوف المختلفة،
تقف اليوم موقف المتفرج على غرق سفينة التعليم الاجتماعي التضامني في سبيل تسليع
معارف تقنية لخدمة مصالح الرأسمالية.
ما دور
القطاع الخاص في دعم المنظومة التعليمية؟ في إطار تنويع مصادر تمويل المدرسة
العمومية، لماذا لا تفرض مساهمة قارة على المؤسسات التجارية و الشركات الكبرى
لفائدة المؤسسات التعليمية الموجودة في الجهة التي تنشط بها هذه المؤسسات؟ لقد
أضحى الآن واجباً وطنيا اقتطاع "ضريبة النهوض بالمدرسة" من جيوب
المستثمرين المحليين والأجانب، كل حسب أرباحه و أنشطته الاقتصادية، إذ من يتاجر في
الحليب ليس كمن يتاجر في الكحول والقمار.
لقد أصبح من
الضروري تقنين عملية جمع التبرعات ووضع إستراتيجية لإبرام شراكات مع مختلف الجهات
الفاعلة في المجتمع بما فيه من منظمات مدنية و مؤسسات اقتصادية وشركات كبرى و
مؤسسات تعليمية حرة، كما تقتضي الظروف الراهنة تكتل مكونات المجتمع المدني
والمثقفين والسياسيين في جبهة وطنية للحفاظ على التعليم الاجتماعي، و محاربة تعليب
التعليم في وصفات جاهزة بأسلوب ماكدونالدز في بناء منارة الفكر والإبداع، فبدون
تعزيز دور العلوم الإنسانية في ترسيخ قيم المجتمع ومبادئه النبيلة من أجل تقوية
أواصر الترابط الاجتماعي ومحاربة تفككه، سينهار لا محالة من جراء الهزات الرأسمالية
و فوضاها الخلاقة.
ذ. محمد
معروف، أستاذ بجامعة شعيب الدكالي


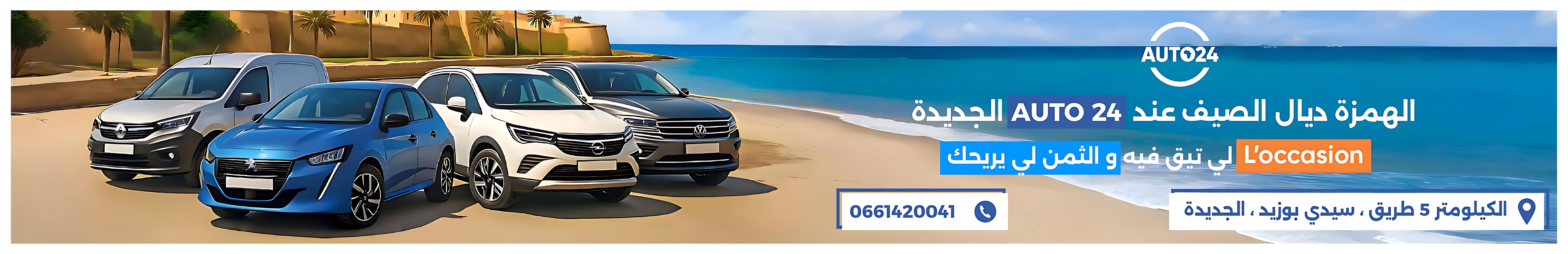


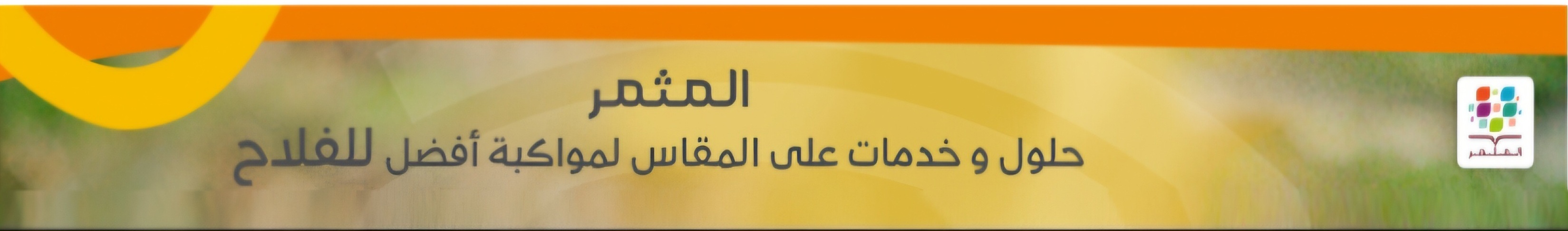









الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة