منطلق هذا المقال هو إنجاز تعليق مختلف عن النقاش الذي ظهر على هامش الحلقة التي استضافت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الإجتماعية "بسيمة الحقاوي"، في برنامج "مباشرة معكم"، والنقاش الذي تلاها على مواقع إلكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي؛ فالنقاش بدأ بالحديث عن مسألة المساواة، وآليات تفعيلها، ومدى تحمل الفاعل الحكومي الحالي مسؤولية تعطيل هذا المبدأ الدستوري، لينتهي كما هي عادة "النقاشات الانفعالية"، إلى تبادل الاتهامات التقليدية "متدين/غير متدين"، وكأن قدر النقاش حول المرأة دوما هو أن ينتهي نهاية مأساوية كهذه: اتهام طرف باحتكار الدين، واتهام الطرف الآخر بمعاداة قيم المغاربة، والنتيجة هي برنامج تلفزيوني للصراخ قد يصفه البعض بأنه "حوار الطرشان"... والضحية الأولى والأخيرة هي المشاهد المغربي..
حتى لا أصبح طرفا في نقاش تلفزيوني عابر، واتجه للمشكلة بشكل مباشر، فإني ازددت قناعة، بعد نهاية البرنامج، أن أكبر معيقات إنجاز نقاش عمومي مفيد حول المرأة و المساواة، هو احتكار "السياسيين"، ومن يدور في فلكهم، النقاش حول هذا الموضوع؛ بينما المشكلة في عمقها ليست سياسية أبدا، بل أكاد أجزم إن أكبر المسيئات للقضية النسائية هن بعض المدافعات عنها أو من يدعين الدفاع عنها وبعض المتكلمات باسمها، سواء من التيار الإسلامي أو التيارات الأخرى...، فالمسألة ثقافية وتربوية وينبغي أن يتم تشخيصها على أنها كذلك، وحلولها تتم من خلال مؤسسات التنشئة الإجتماعية الأصلية: الأسرة والمدرسة، رغم أن هاتين المؤسستين كثيرا ما تتأثران بالمعطى السياسي.
ترى أي أهمية للتربية والثقافة في تصحيح وضعية "الإعاقة" التي تعيشها المرأة في المغرب؟ ماذا نفهم من تواجد مرأة وحيدة في حكومة يفترض أن تكون مفعلة لدستور يتبنى مبدأ المساواة؟ والأخطر: ماذا نفهم من توالي إسناد منصب وزارة تعنى بالأسرة دائما للمرأة؟ ألا يكرس هذا المنطق التقليدي الذي يجعل الأسرة شأنا نسائيا محضا؟ لماذا حتى الآن لم تنل المرأة المغربية ثقة تدبير قطاعات حيوية كالأوقاف، الخارجية،والداخلية؟
إن كل مَن جرد فكره للنظر في وضعية المرأة في المغرب، سيجد انفصاما خطيرا بين الخطاب الحداثي للحركات النسائية والأشكال الفعلية للعلاقات الاجتماعية، وهذا الانفصام جعل من الخطاب النسائي يتخذ أحيانا بعدا نخبويا أو حتى فئويا، مما يحد من فعاليته، والدليل على ذلك، هو أن "انتزاع" الكوطا النسائية على مستوى التمثيلية البرلمانية، عبر "مخرج" اللائحة، لم يكن كافيا لتحريك مجموعة من القضايا ذات الشأن بالأسرة و المرأة، مما يزكي الطرح الذي يسير في اتجاه أن الكوطا ليست الاختيار الأمثل لتجسيد مبدأ المساواة بقدر ماهو مجرد تأنيث للمناصب، ولأن المسألة يُنظر لها على أنها مجرد تأنيث وجبر للخاطر..فإن هذا ما يفسر أن تكون وزيرة وحيدة في حكومة ما بعد الدستور الجديد..وكأن الفاعل السياسي لم يقتنع بعد ب"أداء" النساء كبرلمانيات ليسمح بتعدد الوزيرات..
يبدو أن الفاعل السياسي لم يقتنع بعد بمبدأ المساواة، والمنطق الذي يحكم علاقته بالمرأة لا يتعد منطق الشفقة وفي أحيان أخرى مجرد "ديكور" يؤثث ركوبنا قاطرة الديموقراطية؛ فأن تكون في الحكومة امرأة واحدة معناه أن منطق الأقلية هو الذي يحكم نظرة السياسي الحكومي للمرأة، وهذا يعوق تشكل "لوبي نسائي" حقيقي في قضايا المدونة والتربية والإعلام وغيرها.. إن مطلب "الكوطا" الذي تم تبنيه من طرف الدولة وكذا من طرف الأحزاب والجمعيات، مجرد اختزال للقضية بل وإساءة لشرعية مطالبها، لأنها لا تَعْدُ أن تكون محض "بروتوكول" تفرضه "الموضة"..
فإشكالية المساواة لا تحل بمجرد أن يأخذ الرجل قرار تأنيث الأجهزة الحزبية والمكاتب السياسية، أو حتى الوزارات والمناصب الإدارية و الترابية، بل تحل وفق مدخل ثقافي و تربوي آخر هو ترسيخ ثقافة المساواة على مستوى السلوكات والأحكام، وهو رهان تاريخي لا يقبل أنصاف الحلول وأشباهها، فالكوطا النسائية تأجيل للحل وليست حلا، لأنها التفاف على المطلوب تاريخيا اتجاه هذه القضية ونقصد البدء بخلخلة البنيات الذهنية والثقافية التقليدية لصالح وضعية تحترم مواطنة المرأة وتصون كرامتها. هذا الرهان يمر عبر مسالك تربوية وإعلامية، حيث تبقى للتشريح الثقافي قيمة وجودية في ثقافة الذكورية أو"الفحولية" كما تحب المفكرة التونسية "رجاء بن سلامة" تسميته في كتابها "بنيان الفحولة".
هذه الثقافة المراد تشريحها، تقوم على عنصرين غير متوازنين، الرجل فاعل والمرأة منفعل، فالفاعلية المسنودة على نحو ثقافي صارم للرجل في اللغة والأسرة والسياسة والإدارة وغيرها، في مقابل المفعولية أو الانفعال المرتبط بالمرأة، جعل مسألة الذكورة والأنوثة تؤخذ أحيانا كثيرة على نحو غيبي، كأن نجد من يعتقد أن الذكورية امتياز ثقافي، لأنها رمز لاستمرارية الشرف والعرق والثروة، لذلك نفهم كيف وضعت لهذا الامتياز قواعد عرفت بعلم الأنساب، واليوم لازالت القواعد ذاتها، ففي الثقافة العامية، لازالت المرأة هي ذلك الـْ"حَشَاكْ" الذي ينبغي ذكره رمزا "الوليةّ" أو "ماليين الدار" إلى غير ذلك من الاستعارات والأحجبة، في تقاسم ثابت للأدوار، تكتفي فيه المرأة بأدوار خلفية وراء نجاح كل رجل، أو في أدوار " مسترجلة"، تستلب أنوثتها أو هكذا ما ينبغي لها سلفا أن تتقمصه، و بلغة الشاعر العربي النابغة الذبياني، فهي كحال "الدجاجات التي عليها أن تصيح صياح الديكة".
إن مفاتيح المسألة النسائية اليوم هي تغيير الذهنيات لا القوانين، والذهنيات تتغير بالتنوير الثقافي والتربوي، في أفق تفكيك وتشريح أسس هذه الثقافة الذكورية، ثقافة لن تمحوها اليوم هدايا أعياد المرأة والحب التي يقدمها ذوي ربطات العنق لعشيقاتهم، ف"فحول" القرون الغابرة هم أنفسهم "فحول" الأزمنة المعاصرة، وإن تغيرت أساليب التعبير عن ذلك، وهذا ما لايمكن للسياسيين القيام به، وحدهم المثقفون الحقيقيون يقدرون على ذلك، وهذا ماغيبه "جامع كلحسن" في حلقة برنامجه حول قضية المرأة.
رشيدة لملاحي
صحفية


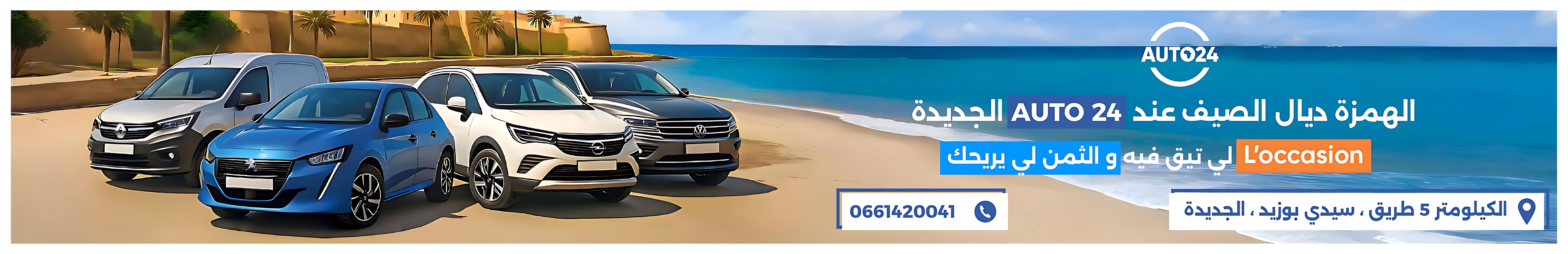


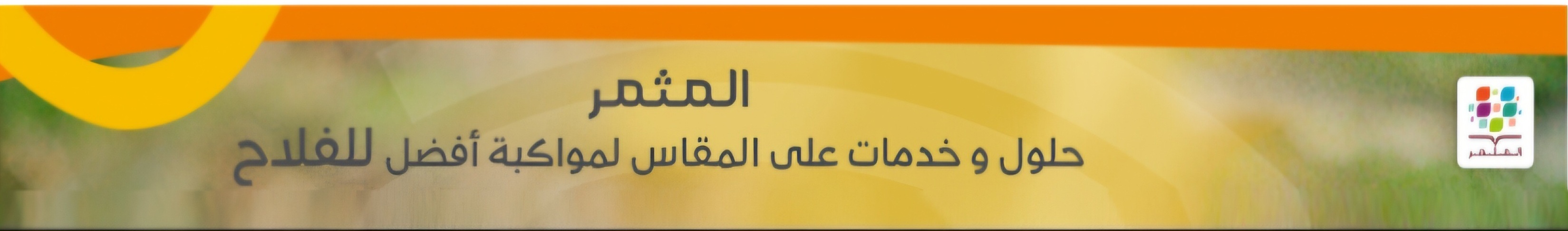









الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة