تتسارع أحداث الريف و تتجه نحو التعقيد، و
تتعدد التساؤلات حول مآل الحراك و إمكانية الحوار والحل. غير أن مؤشرات الواقع لا
تبشر بحل سريع للأزمة و يبقى التساؤل حول أسباب غياب حوار و مفاوضات بين السلطة
المركزية و زعماء الحراك سؤالا مشروعا يستحق التأمل و البحث لأننا نشترك جميعا
كمغاربة في المصير و المستقبل. أود أن أطرح نفس السؤال بهدوء و بمسافة نقدية تبتعد
عن الانخراط الإيديولوجي المباشر مع أو ضد أي طرف رغم أن موقف الباحث في تحليله
النقدي للخطاب هو دائما بجانب العدل و الحق و الممارسة الديمقراطية السليمة. لكن
الخروج من الأزمة يحتاج إلى البحث عن مدخل مناسب للتحليل يستحضر خصوصية النظام في
المغرب أولا، و ثانيا آليات الحوار في السياق المغربي، و ثالثا علاقة السلطة
المركزية مع المجال العام كمجال للمقاومة و الاحتجاج و كذلك للمداولة الديمقراطية،
و رابعا المعيقات باختلاف تلاوينها التي تحول دون فهم متبادل بين السلطة و
المحتجين.
إن النظام المخزني الذي نعيش في ظله اليوم هو بنية لها محددات
تاريخية و لها سلطة قاهرة تتحكم حتى في أقوى الفاعلين الذين يشتغلون بداخلها. من
وجهة نظر ثقافية فعامة الناس هم مشتركون في هذه البنية سواء بتأييدها و دعمها أو
مقاومتها، و ما أكثر من ينتقدونها و لكنهم
في نفس الوقت يعيدون إنتاجها في مستويات مختلفة. تاريخيا فإن بينية النظام مؤسسة،
حسب تعبير عبد الله الحمودي، على ثلاثة مبادئ هي البيعة و اللدنية و التحكيم، أي
الإجماع، النسب الشريف و تموقع الملك خارج الصراع كحَكَم بين الأطراف السياسية
المتصارعة، زوايا، قبائل أو أحزاب أو أي تكتلات أخرى. كما أن النخبة الحاكمة
محكومة بتوسيع قاعدتها و ضمان ولاءات القوى الاجتماعية و السياسية البارزة، و لكن
الدخول ضمن هذه النخبة، أي فئة الخاصة، يتم عبر ثلاثة إجراءات و هي التقرب، الخدمة
و الهبة. فالتقرب و خدمة دار الملك يمنح المتقرب والخادم الامتيازات و يعفيه من
المعاقبة في حالة الخطأ أو الفشل، و هذا الأمر رغم طابعه التاريخي مازال واقعا
ليومنا هذا [خدام الدولة و الوزراء الفاشلين].
كما أن التقرب و الخدمة لا يمكنهما أن ينتعشا إلا بالكرم أي الهبة.
فالأمير، حسب تعبير الحمودي، يقبل الهبة لكنه ليس مجبرا على رد الدين أو الهبة، بل
يهدي حضوره [كحاكم و حكم] مقابل خيرات هذا العالم.
السلطة المخزنية مبنية على التبعية وعدم
المساواة، و قوتها لازمة في أعين الجميع من أجل بناء الأمة. و هي لا تنتصب إلا
باللدنية و القوة الذين يشكل اقترانهما قهرا منظما أو رعبا يتم من خلاله التصرف في
الناس و الأشياء. تلجأ السلطة إلى العنف و لكن كذلك لتوازن القوى لتثبيط همة
منافسيها، لكن ما أن يصبح التنافس على السلطة مفتوحا في شكل عصيان مدني أو رفض
لأداء الضرائب أو مساءلة شرعية الحكم، فإن الضغط العسكري أو الاستعمال المباشر
للعنف و آليات الإذلال كحز الرؤوس، و الإعدام في الساحة العامة و التطواف والسجن
في قفص من حديد و غيرها من الممارسات تصبح ضرورية للنظام لاسترجاع هيبته و هيمنته
على الوضع العام. لقد اختفت الكثير من هذه الممارسات التي شهدها تاريخ المغرب لكن
المبدأ وراءها مازال قائما : الأمير لا ينافس.
إدا كان الأمير لا ينافس فذلك من طبيعة النظام
الذي يضع الحاكم في مرتبة الحكم و يفترض فيه العدل و ضمان الاستقرار و الوحدة و
ضمان السيادة. هذا واقع مازلنا نعيش فيه رغم أن الظروف العالمية و حتى الداخلية
تدفع في اتجاه احترام حق المعارضين السياسيين و الدفع في اتجاه حكم ديمقراطي، و
حتى محاولات الملك في بدايات حكمه كانت تصب في هذا الاتجاه. لكن البنية تعيد إنتاج
نفسها و إن تغيرت الأشكال فجوهر الممارسات و البنية التي تدعمها مازال يحتفظ بقوته
الخفية و سلطته على من يشتغلون بداخلها. قد يدخلنا هذا النقاش في جدلية البنية و
الفعل، و لتجاوزها نُسلم بوجود تقدم و تراجعات ونقر بأن التغيير السياسي يحتاج
لوقت أطول حتى يتم و ينضح التغيير على المستوى الاجتماعي و الثقافي، رغم إيماننا
بأن السياسية يمكن أن تلعب دورا مهما في تسريع التغيير.
إذا كان هذا واقعا، و الذي يجب حتما تغييره، و
لكن حتى يحصل ذلك، يجب التعامل معه ببراغماتية و تبصر. و سأحاول أن أقارب ما حدث
في الريف من وجهة نظر تداولية لسانية و ثقافية، قبل التفكير في السياسي. هناك
مخاطَب و هو الملك، أي الأمير الذي تفترض بنية الحكم أنه لا يُنافس لأنه يتوفر على
شرعية اجتماعية و ثقافية و سياسية و تاريخية أيضا، و مخاطِب الذي هو فرد من عامة
الشعب. من الوهلة الأولى هناك مسافة اجتماعية كبيرة و علاقة سلطة غر متكافئة و
هناك درجة عالية من الحساسية خاصة بموضوع التخاطب من الناحية الثقافية، حتى لا
نتكلم عن الناحية السياسية. إذا ما استعملنا المفاهيم الخاصة بنظرية التأدب في
اللسانيات التداولية [براون/لفسن]، و حتى لا ندخل في التفاصيل، فإنه في أي تخاطب
يمكن أن يكون فعل الكلام مهدِدا لوجه المتكلم أو المخاطَب، و يسمى هذا المفهوم
"فعل تهديد الوجه"Face Threatening Act
(FTA) . ما صرح به الرفزافي و الخطب التي
ألقاها في حراك الريف كانت مهددة، بالمعنى الخاص بهده النظرية، للوجه الإيجابي
للملك من حيث أنها تضمنت أفعالا كلامية تضع نرجسية المخاطَب في خطر كالنقد و
التهديد و اللوم و استعملت أسلوب الاستلزام الذي يحمل معاني غير مصرح بها لكنها
حاضرة في مستوى ثان من الخطاب، نذكر من بينها عبارة "عاش الشعب" التي
تنفي عبارة أخرى موجودة و منتشرة في الخطاب الرسمي و الشعبي و هي عبارة "عاش
الملك". رغم أن مُحرِك الحراك المصرح به هو المطالب الاجتماعية ،فإن ما قيل
يحمل معه مطالب سياسية لا يمكن إلا أن تضع الوجه الإيجابي للحاكم في خطر و خصوصا
في سياق ثقافي مغربي لا يعرف شكلا للسلطة إلا في القوة و القهر المنظم و لا يعترف
بالحكم إلا لمن يمتلك تلك القوة و يهيمن على المجال العام المادي و السياسي[جيمس ساتر].
من هنا ندرك صعوبة التجاوب مع مطالب الريف
بطريقة غير أمنية لأن التحدي كان أكبر من المتوقع سياسيا و ثقافيا و لأن نرجسية
الحكم ما زالت تحاول استعادة هدوءها. إدا كانت القضية بالأساس تتمثل في البنية
السلطوية المتحكمة بتاريخها و حاضرها و صعوبة تغييرها ، وفي طرق المخاطبة غير الملائمة من الناحية
الثقافية، فأن هذا لا يعني أنه من الناحية السياسية يمكن الدفع باتجاه تغيير الوضع
السائد. لكن هذا واقعنا و نصفه على أمل تغييره. التغيير يبدأ من تجاوز بعض
المعيقات/العوائق الإبستيمولوجية [باشلار] التي تحول دون السير قدما نحو تغيير
حقيقي يكون ثقافيا في جوهره و سياسيا في إنجازاته.
أولى هده المعيقات/العوائق هو مفهوم الحكم
بالدونية و الذي يتحكم في سلوك النظام السياسي في المغرب، حيث يحرص النظام على
الإخضاع لضمان الهيمنة، و هذا النوع من التعامل مع المواطن و النخب السياسية لا
يمكن بكل بساطة في التعبير أن يساعد على بناء ديمقراطية. ثاني هذه المعيقات هو
تجاهل رأي الآخر والرأي العام عموما، بحث أن النظام رغم انصاته الدقيق لما يجري في
الساحة السياسية فإنه يتشبث بعدم تلبية المطالب إذا ما كان مصدرها معارضة
راديكالية أو إذا ما تم إيصالها بطريقة غير لائقة من وجهة نظره. أعتقد أن النظام
يحاول أن يوهم المواطن و المتتبع عموما بأن الوسيلة الوحيدة لأي تغيير هي المؤسسات
التي يتحكم فيها، في حين أن سماحه بتوسيع المجال العام ليشمل حتى مواقع التواصل
الاجتماعي قد يزيد من شعبيته و مصداقيته. احتواء المطالب و المعارضة لا يلغيها بل
فقط يؤجلها. العائق الثالث هو الاعتقاد في خطورة التغيير، من حيث أن التيارات
السياسية و الاجتماعية الفاعلة تعتقد أن التغيير لا يجلب إلا الشر في حين لو أن
النظام و التيارات السياسية سارعت إلى إحداث تغييرات حقيقية لكانت أفيد للنظام
نفسه و للحياة السياسية. العائق الأخير هو
هيمنة التمثل الإيديولوجي للواقع تحث تأثير الصراع [الحقد] الطبقي. هذا التأثير
يعيد إنتاج نفس النموذج الذي نسعى إلى تغييره. فاذا كان النظام يشيطن المعارض
الراديكالي، فإن ذلك لا يفيده على المدى البعيد رغم السلطة لتي يتوفر عليها.
الأجدر بالمعارضة و المقاومة السياسية أن لا تراهن على شيطنة النظام و الحشد ضده
بطريقة عاطفية و غير واقعية، بل النقد يتم عبر طرح البديل و عدم الانجرار نحو بث
روح عبثية و عدمية غير ضرورية للتغيير و للاستقرار على المدى البعيد.
زبدة القول، نحن شركاء في النظام و نعيد
إنتاجه، لذلك فليس النظام وحده مطالب بالتغيير بل كل شرائح المجتمع. التغيير هو
تحقيق نموذج أحسن يحافظ على المكتسبات و يحقق التوقعات.
أستاذ باحث بجامعة أبي شعيب الدكالي


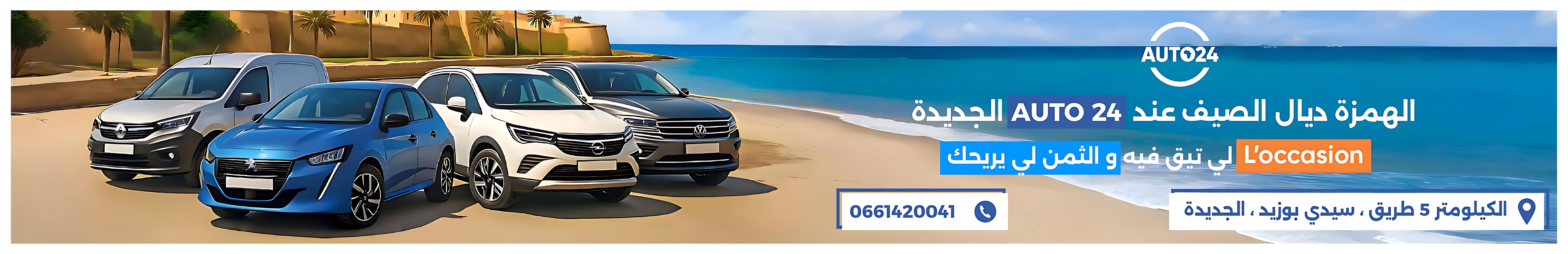
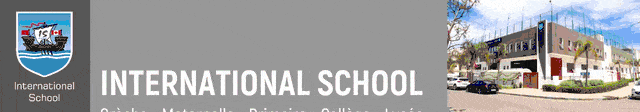

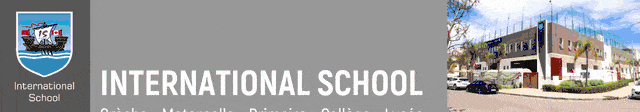


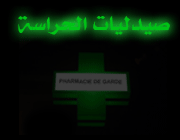
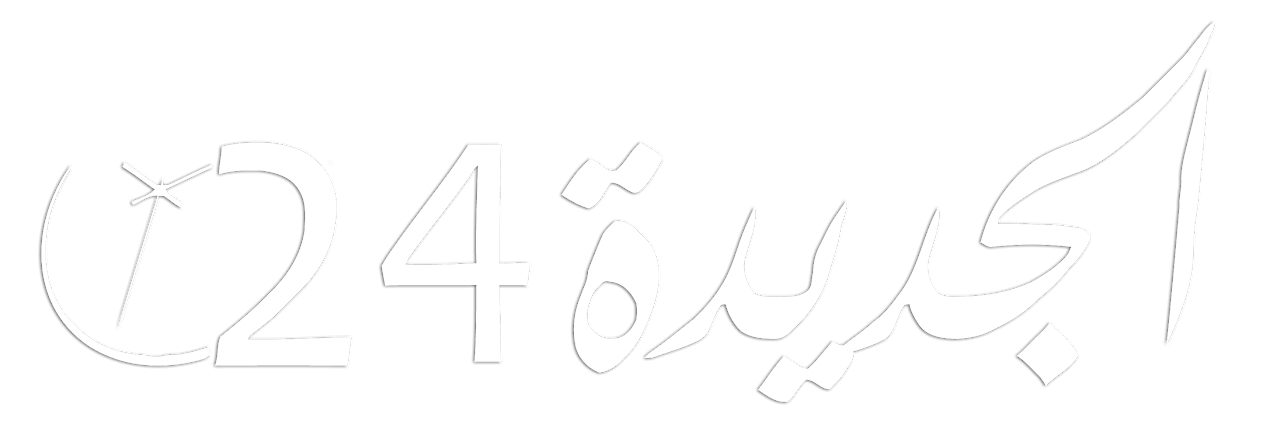





الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة