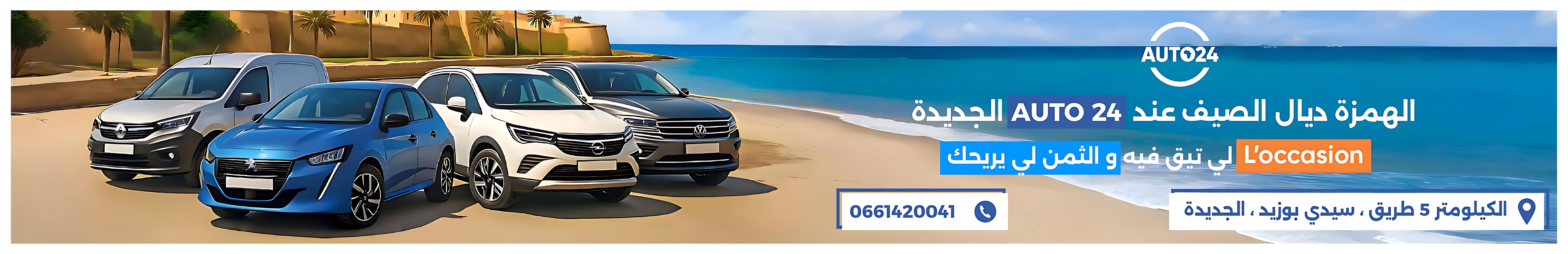بالصور ... مؤسسة صوفاك للقروض تنظم يوماً تواصلياً لفائدة المتقاعدين بالجديدة
نظمت مؤسسة صوفاك للقروض، يوم الاثنين 16 فبراير 2026، يوماً
تواصلياً وتحسيسيا لفائدة المتقاعدين المنتمين إلى عدد من القطاعات، من بينها "
مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، وقطاع السككيين، والصحة، والتعليم، الامن الوطني ، مرسى المغرب ، شركة طاقة المغرب إضافة إلى
فئات أخرى.
واحتضن هذا اللقاء أحد المنتجعات السياحية" زيراد " بضواحي الحوزية، في أجواء اتسمت
بحسن التنظيم والتواصل المباشر مع الحاضرين.
واستهل البرنامج بتحية العلم وأداء النشيد الوطني، تلتها قراءة
سورة الفاتحة ترحماً على أرواح المتوفين بعد ذلك، ألقت السيدة سميرة بيزران، مديرة
وكالة صوفا كريدي بالجديدة، كلمة ترحيبية أبرزت فيها أهمية هذا اللقاء في تعزيز
جسور التواصل مع فئة المتقاعدين وتقديم شروحات حول الخدمات المالية المتاحة لهم.
كما القى السيد أحمد المباركي، رئيس الجمعية الوطنية لجمعية
المتقاعدين بالمغرب، نوه فيها بهذه المبادرة التي تندرج في إطار مواكبة المتقاعدين
وتقديم الإرشاد اللازم لهم بخصوص حقوقهم ومستجدات أنظمة التقاعد ثم عرض للسيدة
حليمة البيار مديرة في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR ، حيث قدمت
شروحات مفصلة حول المساطر الإدارية، وآليات الاستفادة، والمستجدات المرتبطة
بالتقاعد ، كما تمت الإجابة على اسئلة الحضور .
وتضمن البرنامج ثلاثة عروض تأطيرية :
الأول للسيدة حليمة البيار مديرة في نضام الجماعي لمنح رواتب
التقاعد RCAR ، حيث قدمت عرضا
تأطيريا شاملا استعرضت فيه ابرز مستجدات
وخدمات النظام لفائدة المنخرطين والمتقاعدين ، وآليات الاستفادة، والمستجدات
المرتبطة بالتقاعد كما تمت الإجابة على اسئلة الحضور .
العرض الثاني للسيدة سميرة بيزران مديرة وكالة صوفا كريدي بالجديدة
تطرقت فيه الى مختلف العروض والخدمات التمويلية التي توفرها الشركة لفائدة
المتقاعدين، خاصة القروض الشخصية وشروط الاستفادة منها، مع تقديم شروحات دقيقة حول
مساطر دراسة الملفات، ونسب الفائدة، وآجال السداد، وكذا الامتيازات الخاصة بهذه
الفئة.
العرض الثالث لممثل الصندوق المغربي للتقاعد CMR
السيد محمد يسين باعدي تطرق فيه الى مجموعة من المحاور الأساسية
المرتبطة بنظام التقاعد، كالتعريف بالصندوق واختصاصه، أنظمة التقاعد التي يدبرها
الصندوق الخدمات الرقمية وتبسيط المساطر ...
اليوم التواصلي تخللته فقرات موسيقية من أداء الفانة ايمان لزرق بالإضافة
الى فقرات شعرية وزجلية للشاعرة فتيحة بلالي ونجح في تقديم فقراته السيد الحسني
محمد، رئيس جمعية متقاعدي السككيين بالجديدة، الذي حرص على تنظيم فقرات اللقاء
وضمان تفاعل الحاضرين مع مختلف المتدخلين.
كما شارك في تأطير هذا اللقاء كل من السيد عبد الرحمان جعفري
المدير الجهوي لمؤسسة " سوفاك كردي " والسيد أسامة بن صالح، المسؤول عن
التواصل والمكلف بالقروض الشخصية، والسيد أيوب بردان الذي يشغل نفس المهام، حيث
قدما توضيحات عملية حول كيفية إيداع الطلبات، والوثائق المطلوبة، وآليات تتبع
الملفات إلى حين صرف القرض.
وقد شكل هذا الموعد مناسبة للتعريف بمختلف العروض والخدمات
التمويلية التي توفرها الشركة لفائدة المتقاعدين، خاصة القروض الشخصية وشروط
الاستفادة منها، مع تقديم شروحات دقيقة حول مساطر دراسة الملفات، ونسب الفائدة،
وآجال السداد، إضافة إلى الامتيازات المخصصة لهذه الفئة وكانت مناسبة لتعزيز
التواصل المباشر مع المتقاعدين، والإجابة عن استفساراتهم، وتوضيح مختلف الخدمات
والمنتجات الموجهة لهذه الفئة.