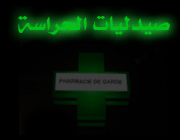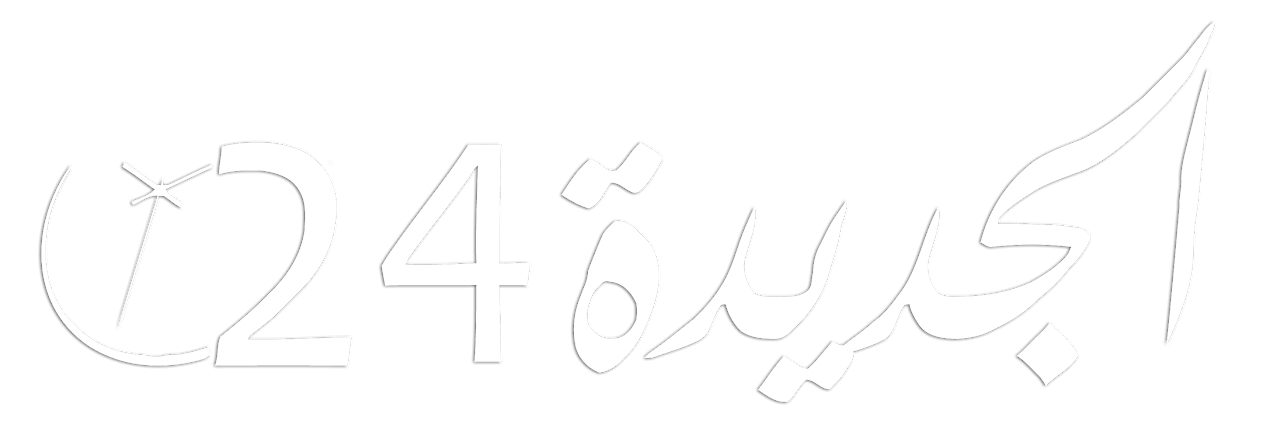-
صناعة الشك والحرب النفسية الرقمية في كأس إفريقيا بالمغرب
لم تكن كأس إفريقيا الأخيرة للأمم مجرد منافسة رياضية، بل تحوّلت إلى ساحة مواجهة رمزية ونفسية، لعبت فيها وسائل التواصل الاجتماعي دورًا حاسمًا في توجيه الرأي العام المحلي والإقليمي، وصناعة الشك، والتشويش على الوعي الجماعي. فما جرى خلال البطولة كشف هشاشة الإعلام المحلي في السيطرة على المجال العام الرقمي المغربي أمام حملات ممنهجة من التضليل، وغياب قدرة فعّالة على إنتاج خطاب إعلامي مضاد يواجه هذا النوع من الحروب النفسية.لم تبدأ هذه الحرب النفسية مع كأس إفريقيا. بل يمكن تتبّع جذورها إلى ما جرى سابقًا داخل فضاءات رقمية مثل Discord، حيث قامت مجموعات من جيل Z بإنشاء حسابات وهمية، وإطلاق حملات تعبئة افتراضية ضد الدولة المغربية ومؤسساتها، حاملة شعار لا للملاعب ومقاطعة كأس افريقيا. هذه الحملات، التي اتخذت أحيانًا طابع “المقاومة الرقمية”، ساهمت في نزول بعض الشباب إلى الشارع، خاصة من أوساط يسارية وإسلامية، دون إدراك أن كثيرًا من هذا الغضب كان موجَّهًا ومُصنَّعًا رقميًا.ظهرت كذلك مجموعة "جبروت"، التي قدّمت نفسها كجماعة هاكرز، وهدّدت بكشف “أسرار خطيرة” عن مسؤولين وسياسيين مغاربة. لم يكن الهدف هو كشف معطيات بغرض النقد البناء أو الشفافية، بل فرض مناخ ابتزاز نفسي، وبثّ الخوف، وإرباك الثقة في الدولة والمؤسسات. كان ذلك تمرينًا مبكرًا على التحكم في المجال العام الافتراضي عبر الخوف والفضيحة المتخيَّلة. وانتقلت من تقديم نفسها كجماعة ضغط سيبراني إلى لعب دور داعم ومُضخِّم لسردية "الفساد" التي رافقت كأس إفريقيا. فبعد خروج المنتخب الجزائري من المنافسة، تصاعد خطاب التهديد والوعيد الموجَّه إلى الدولة المغربية، مقرونًا بإيحاءات حول "ملفات" و"أسرار" مزعومة. لم يكن هذا الخطاب معزولًا عن المناخ العام للحملة الرقمية، بل انسجم معها وساهم في تعميق مناخ الشك، عبر تحويل الإحباط الرياضي إلى ضغط سياسي رمزي. بهذا المعنى، لم تعمل جبروت على كشف وقائع مثبتة بقدر ما أسهمت—من خلال التوقيت واللغة والتضخيم—في إسناد رواية تشكيكية تُعيد إنتاج اتهام المنظومة، وهو ما عزّز أثر الحرب النفسية الرقمية المصاحبة للبطولة.كأس إفريقيا: انتقال الحرب النفسية إلى المجال الرياضيمع تنظيم كأس إفريقيا في المغرب، انتقلت هذه الحرب النفسية إلى المجال الرياضي. منذ البداية، حيث اشتغلت شبكات من الحسابات الوهمية، إلى جانب مؤثرين وإعلاميين جزائريين، وآخرين من الشرق الأوسط وبعض الدول الإفريقية، على بناء سردية مفادها أن فوز المغرب سيكون بالفساد، عبر رشوة الحكام وشراء المباريات. هذه السردية تجاهلت تمامًا المعطيات الموضوعية: فالمغرب فريق قوي، أثبت قدرته في كأس العالم، ويمتلك بنية تحتية وتنظيمًا احترافيًا. ومع ذلك، جرى التعامل مع نجاحه المفترض باعتباره دليلًا على الفساد لا على الكفاءة. هنا لا نتحدث عن نقد رياضي، بل عن تشويه ممنهج للسمعة، يهدف إلى نزع الشرعية الأخلاقية عن أي إنجاز مغربي.والأخطر في هذا السياق أن الاعلام المغربي الهش أصلا لم يُبدِ أي مقاومة حقيقية لهذه السرديات. بل على العكس، وقعت بعض وسائله صحبة مؤثرين مغاربة في الفخ، حين بالغوا في خطاب الانتصار المسبق، وكرّسوا فكرة أن الكأس ستبقى في المغرب، بل ووصل الأمر بالمغاربة إلى إنتاج أغانٍ وشعارات تؤكد هذا المعنى: "لاكوبا غا تبقى هنايا". وبهذا السلوك، ساهم الإعلام نفسه – دون وعي – في تغذية سردية الفساد التي كان الخصوم يروّجون لها. وبدل تفكيك خطاب الاتهام، جرى تعزيز مناخ الشك، وإعطاء الذخيرة الرمزية للحملات المعادية. بلغت هذه الحرب النفسية ذروتها في المباراة النهائية بين المغرب والسنغال، حين انسحب المنتخب السنغالي من أرضية الملعب بشكل مؤقت بعد قرار تحكيمي، إذ لم يكن هذا السلوك مجرد احتجاج رياضي عادي، بل كان تعبيرًا عن ذهنية مشبعة بسردية مسبقة: اللعب مع المغرب هو لعب ضد "منظومة فاسدة". هذا السلوك لا يمكن فصله عن المناخ الإعلامي والنفسي الذي سبق المباراة، ولا عن ثقافة الاتهام والتشكيك داخل بعض دوائر CAF، حيث يُنظر إلى النجاح لا بوصفه نتيجة عمل وتنظيم، بل نتيجة تلاعب ومؤامرة.الحرب النفسية كإطار لفهم ما جرىما حدث خلال كأس إفريقيا للأمم لا يمكن اختزاله في تنافس رياضي أو سجال إعلامي عابر، بل يندرج ضمن ما يسميه الباحثون في هذا المجال بالحرب النفسية منخفضة الحدة. إذ لا تنجح الحملات النفسية عبر القوة الصلبة، بل عبر التراكم البطيء للرسائل المشكِّكة، وإضعاف الثقة، وزرع الشك في النوايا والشرعية، خاصة عندما تستهدف جمهورًا واسعًا في لحظة تعبئة رمزية كبرى مثل البطولات الرياضية. في هذا السياق، لم يكن الهدف إقناع الجمهور الدولي بأن المغرب "فاسد"، بقدر ما كان خلق مناخ دائم من الشك، يجعل أي نجاح مغربي مشكوكًا فيه سلفًا، وأي تنظيم محكومًا عليه بالريبة. تشير أدبيات الحرب النفسية إلى أن من يسيطر على السردية الأولى يمتلك أفضلية حاسمة. فالأكاذيب، حين تُزرع مبكرًا، تلتصق بالوعي الجماعي ويصعب نزعها لاحقًا، حتى وإن فُنِّدت بالأدلة. ويلاحظ أن الفضاء الرقمي، خصوصًا منصات X وTikTok وYouTube، يضاعف هذه الظاهرة بسبب سرعة الانتشار، وخوارزميات التضخيم، وضعف آليات التحقق. ما جرى هو أن سردية “الفساد” سبقت الوقائع، وتغذت لاحقًا من بعض الخطابات الإعلامية المحلية التي، بحسن نية أو بدونه، ضخّمت خطاب الحسم والانتصار المسبق، مما جعل السردية المعادية أكثر قابلية للتصديق خارجيًا.تُجمع دراسات الحرب النفسية على أن الإشاعة لا تُختزل في كونها معلومة خاطئة أو خبرًا زائفًا، بل تُعد أداة فعّالة للتفكيك المعنوي وإضعاف الثقة الجماعية. فنجاح الإشاعة لا يتوقف على دقتها أو قابليتها للإثبات، بل على قدرتها على التداول السريع، وانسجامها مع مخاوف كامنة ومسبقة لدى الجمهور المستهدف. في الحالة المغربية، استُخدمت الإشاعة كآلية ضغط نفسي لإحداث شرخ مركّب على أكثر من مستوى: أولًا بين الجمهور المغربي ومؤسساته، من خلال التشكيك في نزاهة التنظيم وقدرة الدولة على إدارة حدث قاري؛ وثانيًا بين المغرب ومحيطه الإفريقي، عبر تصوير نجاحه كاستثناء مريب لا كإنجاز مشروع؛ وثالثًا بين التفوق الرياضي والتنظيمي وصورته الأخلاقية، بحيث يصبح كل نجاح موضع ريبة سابقة. هذا الشكل من "الهجوم غير المباشر" لا يواجه الخصم مواجهة صريحة، بل يدفعه إلى الدفاع المستمر عن شرعيته داخل فضاء عام مليء بالشكوك، وهو ما يُضعف موقعه الرمزي بدل أن يعزّزه.ليست الرياضة مجالًا محايدًا أو معزولًا عن منطق الصراع الرمزي، بل تُعد من أكثر الحقول قابلية للاستثمار في الحملات النفسية الحديثة. فهي تعبّئ العاطفة الجماعية، وتُنتج هوية مشتركة مؤقتة، وتُضخّم الإحساس بالكرامة أو الإهانة على نحو يصعب تحقيقه في مجالات أخرى. لهذا، فإن استهداف المغرب خلال تنظيمه لكأس إفريقيا للأمم لا يتعلق بكرة القدم في حد ذاتها، بل بمحاولة تقويض رمزية نجاح إفريقي مستقل، وتحويل حدث رياضي وتنظيمي سيادي إلى موضوع تشكيك. وفي هذا السياق، تصبح المباراة، والقرار التحكيمي، والهتاف، والصورة المتداولة على المنصات الرقمية عناصر ضمن معركة أوسع على المعنى والشرعية، حيث لا يكون الرهان هو الفوز أو الخسارة في الملعب، بل السيطرة على السردية في الوعي الجماعي.معركة الوعي لم تنتهِما جرى في كأس إفريقيا للأمم لا يمكن اعتباره حادثًا عابرًا أو مجرد توتر رياضي ظرفي، بل يشكّل مؤشرًا واضحًا على تحوّل الرياضة إلى أداة ضمن حروب نفسية رقمية متكاملة. هذه الحروب لم تُخَض داخل الملعب فقط، بل أُديرت أساسًا عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وتيك توك، والفايسبوك واليوتوب، وعبر فيديوهات مفبركة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وحسابات وهمية اشتغلت على صناعة الشك، وتشويه السمعة، وتقويض الثقة الجماعية. لقد استهدفت هذه الحملات المعنويات والرمزية أكثر مما استهدفت نتيجة مباراة بعينها، وجعلت من كرة القدم ساحة صراع إدراكي لا يقل خطورة عن الصراع السياسي.ما يجب التأكيد عليه هو أن هذه الحرب النفسية لن تتوقف عند حدود كأس إفريقيا، ولن تكون حدثًا استثنائيًا مرتبطًا ببطولة واحدة. نحن أمام نمط متكرر من الضغط الرمزي، والتشكيك المنهجي، وتفكيك الثقة الجماعية، يُستعمل فيه الإعلام الاجتماعي كسلاح منخفض الكلفة وعالي التأثير. هذا النمط يعتمد على التكرار، وعلى استثمار الانفعالات الجماعية، وعلى تحويل النجاح الرياضي أو التنظيمي إلى موضع ريبة دائم، بما يخلق مناخًا عامًا من الشك يصعب تفكيكه لاحقًا.لهذا، لم يعد كافيًا الاكتفاء بردود فعل ظرفية أو انفعالية، ولا بخطابات دفاعية متأخرة. بل أصبح من الضروري التفكير في بناء مناعة رقمية وطنية طويلة الأمد، قوامها إعلام مهني متخصص في مجالات متعددة، قادر على تسويق المنتوج المحلي، ولا يقع في فخ السرديات المعادية ولا يعيد إنتاجها دون وعي، ويستطيع رفقة التعليم صناعة وعي جماعي بكيفية اشتغال الدعاية الرقمية وآليات التلاعب الإدراكي، ويعمل على إنتاج خطاب هادئ، عقلاني، ومُقنِع، يتقدم بالسردية بدل أن يلاحقها. فالمعركة القادمة ليست على الكؤوس أو على تنظيم البطولات فقط، بل هي معركة على الوعي، وعلى الثقة الجماعية، وعلى القدرة على مقاومة التلاعب النفسي في زمن أصبحت فيه الصورة، والخوارزميات، والذكاء الاصطناعي، أخطر من الشائعة نفسها.ذ. محمد معروف، جامعة شعيب الدكالي
-
أزمة الأخلاق في كرة القدم الإفريقية
أعاد اختتام كأس الأمم الإفريقية وتتويج السنغال بالأمس طرح سؤال قديم لم يُحسم بعد: هل تعيش كرة القدم الإفريقية أزمة أخلاق (ethical crisis)؟ ما جرى خلال البطولة من تشكيك في ذمة البلد المنظم والكاف، يوحي بأن المشكلة أعمق بكثير من أخطاء تحكيمية معزولة أو ضعف تقني لدى بعض الحكّام، إذ نحن أمام ذهنية ثقافية راسخة، باتت ترى الفساد متوقَّعًا، ومقبولًا، وأحيانًا مُدبَّرًا سلفًا. لقد تكررت الإشكالات التحكيمية طوال المنافسات: ركلات جزاء تُحتسب أو تُلغى بلا اتساق، وأخطاء واضحة تُُتجاهل، ولحظات حاسمة في مباريات كبرى تُدار بارتباك. فمن السهل تعليق ذلك على شماعة ضعف الكفاءة، لكن عند تكرار الأنماط نفسها عبر بطولات مختلفة، وبأجيال متعاقبة من الحكّام، وفي بلدان مُستضيفة متعددة، يكشف أن العطب ثقافي ومؤسساتي قبل أن يكون تقنيًا.تعتبر تجربة المغرب خلال هذه البطولة كاشفة لذهنية ثقافية طبعت مع الفساد. فعلى الرغم من استثمارات ضخمة في البنية التحتية والملاعب والطرقات ومراكز التكوين والتنظيم الاحترافي، تعرّض البلد المنظم لحملات اتهام بالتلاعب وشراء الحكّام من دون أي دليل، في خطاب تشهيري يستند إلى افتراض غير مُعلن، مفاده أن النجاح في كرة القدم الإفريقية لا يتحقق إلا عبر الفساد. هنا لم يعد الفساد ممارسة عارضة، بل تصورًا ذهنيًا يحكم الخيال الكروي نفسه.تتضح هذه الذهنية الثقافية (cultural mindset) أكثر عند النظر إلى ردود فعل المنتخبات التاريخية المُهيمنة. فمصر، الأكثر تتويجًا بسبعة ألقاب والأكثر حضورًا في النهائيات، والكاميرون بخمسة ألقاب، والجزائر بلقبين وقد استعادت مكانتها مؤخرًا، والسنغال التي تتوج مرتين، تدخل نادي المتوجين المتكررين، جميعها منتخبات خبرت النهائيات مرارًا. وليس عابرًا أن تكون هذه المنتخبات، المعتادة على المراحل الأخيرة، الأكثر صخبًا في الاحتجاج على التحكيم والطعن في نزاهة بطولة استضافها المغرب. إن احتجاجاتها لا تأتي من خارج المنظومة، بل من داخلها، ومن معرفة دقيقة بالمناطق الرمادية للعبة، حيث يُتصوَّر أن النتائج لا تُحسم داخل الملعب وحده، بل تُدار أيضًا في الكواليس.وهنا يبرز السؤال الحاسم: هل يمكن لمنتخبات بلغت النهائيات بهذا التكرار ألا تعرف القواعد غير المكتوبة لكرة القدم الإفريقية؟ وهل يمكن ادعاء البراءة التامة حين تتكرر الاحتجاجات ومحاولات الضغط في اللحظات الفاصلة؟ أم أن الأصح هو الإقرار بأن تكرار الوصول إلى النهائيات لا يمنح خبرة رياضية فقط، بل يُنمّي خبرة مؤسساتية في كيفية توظيف الضغط والارباك والكولسة والجدل داخل النظام الكروي؟تجلّت هذه الذهنية الثقافية مجددًا في النهائي بين المغرب والسنغال. فعندما احتسب الحكم ركلة جزاء إثر خطأ دفاعي واضح، لم يُقابل القرار بالاحتكام إلى القانون، بل بالاحتجاج وخلق الفوضى، والانسحاب من الملعب، ومحاولة تقويض سلطة الحكم. هذا السلوك يكشف افتراضًا عميقًا: أن النتائج قابلة للتفاوض، وأن السلطة يمكن زعزعتها، وأن الفوضى أداة تكتيكية لإدارة المباريات الحاسمة. هذا ليس سلوك منتخب أو اتحاد كرة، يثق بأن الملعب وحده يحسم؛ بل سلوك تشكّل وعي صاحبه داخل منظومة لا تثق بالقانون إلا بقدر ما يخدم موازين القوة.إن غياب المغرب الطويل عن منصة التتويج منذ 1976 ليس مجرد رقم رياضي، بل هو دليل قاطع ومعطى اجتماعي عن عدم انخراطه في شبكات المصالح والتحالفات غير الرسمية والطقوس غير المعلنة التي تحكم كرة القدم الإفريقية. فالمنتخبات التي اعتادت النهائيات لا تتفوّق فنيًا فقط، بل تُتقن أيضًا التعامل مع تعقيدات بيروقراطية داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. ليست الخبرة هنا فنية فحسب؛ بل إنها خبرة مؤسساتية.هذا التطبيع يتجاوز ضغط المباريات، ليشمل التعايش مع نظام كروي، جرى فيه المزج بين اللعب والنفوذ والمساومة والتأثير والكولسة. ومع الزمن، تبلورت ذهنية ثقافية ترى النجاح حصيلة أداء رياضي وتدبير ذكي داخل منظومة مُختلّة للكاف. وهكذا تصبح النهائيات درسًا في “كيف تُدار الأمور” لا بوصفها منافسة رياضية.أمام هذا الواقع، تطرح أسئلة مُلحّة على الفيفا والهيئات الدولية: هل يستمر تدبير كرة القدم الإفريقية كنظام شبه مغلق قابل للضغط والشبهات؟ أم آن الأوان لرفع السقف عبر آليات مراقبة صارمة، واحتراف التحكيم، وربما الاستعانة بحكّام محايدين من خارج القارة في المباريات الحساسة؟هذه دعوة لحماية اللعبة من عقلية تُقوّض الثقة. فالكرة لا تزدهر إلا حيث تُحترم القواعد وتُصان العدالة. فبدون إصلاح أخلاقي جذري، ستتحول المنافسة إلى مسرح شكوك، يُساءل فيه كل فوز ويُفسَّر كل إخفاق كمؤامرة. إن كرة القدم الإفريقية لا تحتاج إلى ملاعب ولاعبين فقط، بل إلى قطيعة مع ثقافة الفساد المُطبَّع. وحتى تُواجَه هذه العقلية مواجهة صريحة، ستظل جماليات اللعبة، والموهبة، والنجاح رهينة الجدل والارتياب.الأستاذ محمد معروف جامعة شعيب الدكالي
-
من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة
تُقدَّم كرة القدم اليوم، بوصفها لعبة حديثة محكومة بالقوانين والتقنيات والاستراتيجيات، والبث الرقمي، لكنها في عمقها الاجتماعي والثقافي، تحمل في طياتها آثارًا قديمة من الطوطمية، ذلك النظام الرمزي الذي شكّل أحد أقدم الأشكال الدينية لتنظيم الجماعة وبناء الهوية الجمعية. والسؤال المطروح، ليس لماذا تتخذ الفرق الحيوانات شعارات لها، بل لماذا تصمد هذه الرموز الثقافية، وتظل فاعلة إلى اليوم في عالم يُفترض أنه تجاوز العنف البدائي والطقوس الدينية القديمة؟في التصور الأنثروبولوجي الكلاسيكي، ليس الطوطم مجرد رمز زخرفي، بل يرمز إلى المجتمع، وقد أسقط ذاته على رمز حي. فالطوطم يجسّد القوة الجماعية، ويحدد من نحن ومن هم الآخرون، ويخلق حدودًا عاطفية وأخلاقية بين "نحن" و"هم". لقد أعادت كرة القدم بوصفها نشاطًا جماهيريًا كثيف الانفعال إحياء هذا المنطق الطوطمي في سياق رأسمالي، يُسَلِّع الطوطم ويسوقه. إن شعار الفريق، وألوانه، وتميمته، ونشيده عناصر تعمل بوصفها مقومات جماعية شبه مقدسة. والمساس بها لا يُستقبل بوصفه رأيًا رياضيًا، بل باعتباره إهانة للجماعة نفسها، وهنا تتجاوز اللعبة منطق الترفيه لتدَخُل مجال الانتماء والهوية.لم تختفِ خطاطات القتال والمواجهة من الثقافات الحديثة، بل تحوّلت من مجال دموي إلى آخر ناعم، فبينما كان الصراع قديمًا يُحسم بالسلاح والدم، وينحصر في مجال المقدس، صار اليوم يُدار داخل مجال الترفيه في ملعب، وفق قواعد، وزمن وحَكم. وتمثل كرة القدم هذا الانتقال من العنف الفيزيائي إلى العنف الرمزي. فأصبح الفوز نجاة، والهزيمة جرحًا جماعيًا، والهبوط موتًا رمزيًا، والصعود بعثًا جديدًا. وبهذا المعنى، لم تُلغِ كرة القدم القتال، بل مَسرَحته، وجرّدته من الدم مع الحفاظ على شحنته العاطفية؛ إذ تعبّر الطوطمية الناعمة عن الولاء والالتزام العاطفي وتؤدي وظيفة تنظيم الانفعالات الجماعية، كما يعزز القميص الارتباط الجماهيري. يمكن فهم الطوطم، بوصفه خطاطة دينية قديمة كانت تنظّم علاقة الجماعة بالعنف والبقاء، حيث كان الحيوان الطوطمي يُستدعى في طقوس دموية فعلية مرتبطة بالصيد أو الحرب أو التضحية. ومع تحوّل المجتمعات الحديثة، لم تختفِ هذه الخطاطة، بل انتقلت إلى حقل الثقافة الاستهلاكية. في كرة القدم، يُعاد توظيف الحيوان الطوطمي لا للقتل أو الإيذاء، بل بوصفه رمزًا بصريًا قابلاً للتداول، يُعبّئ العاطفة الجماعية داخل إطار فرجوي منضبط. هكذا يتحول الطقس من دمٍ حقيقي إلى عرض رمزي، ومن تضحية جسدية إلى استهلاك بصري، دون أن يفقد الطوطم وظيفته الأساسية التي تكمن في تنظيم الانتماء وضبط الصراع. تقدّم كرة القدم الإفريقية نماذج واضحة للطوطمية الحديثة: المغرب يتخذ طوطم أسود الأطلس: والأسد رمز الشجاعة والحماية والذاكرة، والأسد الأطلسي المنقرض يضيف بعدًا أسطوريًا للبقاء الرمزي. ساحل العاج – الفيلة: وهو رمز الثقل والصبر والقوة الجماعية المتراكمة. نيجيريا – النسور الخارقة: وهو طوطم السيادة والرؤية من الأعلى والحسم السريع. الكاميرون – الأسود غير المروّضة: هذا إعلان صريح للتمرد ورفض الخضوع. السنغال – أسود التيرانغا: وهي قوة مقرونة بالكرامة والضيافة. هذه الحيوانات ليست زخرفة، بل تكثيفا رمزيا لفضائل القتال والبقاء.لفهم عمق هذه الاستمرارية، يمكن استحضار طقس "بوجلود" بالمغرب، حيث يتقمّص الإنسان جلد الحيوان في احتفال جماعي أثناء احتفالات عيد الأضحى، فيجمع بين اللعب والخوف والضحك والتجاوز المؤقت للنظام الاجتماعي. ليس بوجلود فرجة فولكلورية بريئة، بل بقايا طقس طوطمي تُستعاد فيه علاقة الجماعة بالحيوان، بوصفه مصدر قوة وحماية. لا يُمارس العنف هنا فعليًا، بل يُعاد تمثيله وتحويله إلى أداء جماعي يسمح بتفريغ التوتر وإعادة تثبيت الحدود الاجتماعية. وهذا المنطق نفسه نجده في كرة القدم: القناع بدل السلاح، والملعب بدل ساحة القتال.ترجع الطقوس الطوطمية المرتبطة بارتداء جلود الحيوانات إلى أزمنة ما قبل الأديان المؤسسية، وتحديدًا إلى المجتمعات البشرية الأولى القائمة على الصيد. في تلك السياقات، لم يكن جلد الحيوان لباسًا وظيفيًا فقط، بل وسيلة رمزية لاكتساب قوة الحيوان والاتحاد به قبل الصيد أو بعده. ومع مرور الزمن، تحوّل ارتداء الجلد إلى طقس عبوري يتيح للإنسان الانتقال مؤقتًا من حالته البشرية إلى حالة "الكائن الآخر"، جامعًا بين الإنسان والحيوان والروح. وهكذا نشأت الطوطمية بوصفها نظامًا رمزيًا ينظّم العنف الضروري للبقاء، ويحوّل القتل من فعل فوضوي إلى ممارسة مُقنَّنة ذات معنى جماعي. وقد استمرت هذه الخطاطة الرمزية عبر التاريخ الديني، حتى بعد اختفاء الذبيحة الدموية، حيث أعيد توطينها في أشكال حديثة من الطقوس والفرجة والهوية الجماعية. إن هذه الرموز الحيوانية لم تقتصر تاريخيًا على المجال الرياضي، بل استُخدمت على نطاق واسع في الشعارات العسكرية، والتنظيمات القتالية، حيث مثّلت الشجاعة والانضباط والقدرة على المواجهة. وانتقلت هذه الخطاطة الرمزية لاحقًا إلى مجالات أخرى من الحياة الاجتماعية، من السياسة إلى الرياضة، حيث أُعيد توظيفها لتمثيل الصراع والانتماء في صيغ غير دموية وأكثر قابلية للتداول.كما أن لهذه الطقوس الطوطمية أساسًا أخلاقيًا عميقًا يتمثل في محاولة الإنسان تبرير أو مداواة "الجريمة المقدسة" التي ارتكبها في حق رفاقه في الطبيعة. فالصيد لم يكن مجرد فعل تقني لتأمين الغذاء، بل كان اعتداءً وجوديًا على كائن يُنظر إليه بوصفه شريكًا في العالم الطبيعي. ومن هنا جاء الطقس بوصفه فعل اعتراف وتعويض رمزي؛ فارتداء جلد الحيوان، وتقمّص صفاته، وتكريمه عبر الشعائر، كلها وسائل لتحويل القتل إلى علاقة أخلاقية، وإدخاله ضمن نظام معنى يخفف من عبء الذنب. وبهذا المعنى، لا تعمل الطقوس الطوطمية على تنظيم العنف فقط، بل على أخلَقة القتل وجعله مقبولًا داخل أفق مقدّس، يربط الإنسان بالطبيعة لا بوصفها موردًا فقط، بل بوصفها كيانًا ذا حرمة تم انتهاكها ويجب ترميمها رمزيًا.لا تُعاش كرة القدم بوصفها متعة آنية فقط، بل بوصفها سردية بقاء طويلة الأمد، تُبنى وتُدار عبر الزمن. فالجماهير لا تستهلك النتائج كما تُستهلك المنتجات، بل تتحمّل المسار بكل ما فيه من انتظار، وهزائم، وإقصاءات، وتعليق دائم للأمل إلى موسم مقبل. غير أن هذه السردية لا تُنتج تلقائيًا، بل تُصاغ وتُعاد صياغتها عبر شبكة مؤسسية كثيفة، وهناك برامج تكوينية للفئات الصغرى، ودورات إعداد وتحضير، وتربصات مغلقة، واجتماعات تقنية وإدارية، ونشرات إخبارية، وملصقات، وإشهارات، وتعاقدات، وأرشيف بصري وإعلامي يُستدعى باستمرار لتذكير الجماعة بتاريخها ومسارها. بهذه الأدوات، تتحول الهزيمة إلى مرحلة، والفشل إلى درس، والانتظار إلى فضيلة. لا يعيش النادي أو المنتخب في زمن المباراة فقط، بل في زمن ممتد تُغذّيه الخطابات الرسمية، والمؤتمرات الصحفية، والوثائقيات، وشعارات المشروع، وإعادة البناء، والعودة القوية. هنا لا تقول السردية: "انتصرنا أو خسرنا"، بل تقول: "نحن مستمرون".في هذا السياق، يغدو الطوطم أكثر من رمز للقوة أو الشراسة؛ إنه علامة الاستمرارية رغم الخسارة، إذ يسمح للجماعة بأن ترى نفسها قائمة حتى حين تفشل، ومتماسكة حتى وهي تُقصى. فالطوطم لا يعد بالنصر الدائم، بل يَعِد بالبقاء—وهذا، في منطق كرة القدم الحديثة، هو جوهر السردية. تعمل كرة القدم أيضًا، بوصفها مسرحًا اجتماعيًا للمخاطرة والمغامرة، وعدم التيقن من النتيجة، وتقلب الحظ، وإمكانية الانتصار أو الانكسار في لحظة واحدة، حيث تصبح المباراة تجربة قائمة على الرهان الرمزي، وهنا يظهر القمار، والرهانات، والتضحية بالوقت والمال، والانخراط العاطفي الحاد. فالمشجع لا يغامر بجسده، لكنه يغامر بمشاعره وكرامته الرمزية داخل الجماعة. إنها مغامرة بلا دم، لكنها مشحونة بالتوترات الاجتماعية.في العصر الرقمي، انتقلت الطوطمية الناعمة من المدرج إلى الشاشة، فأصبحت الشعارات صورًا شخصية، والمهارات مقاطع قصيرة مصحوبة بالموسيقى، والهزيمة مادة للسخرية الجماعية. ولم يعد الطقس أسبوعيًا فقط، بل دائمًا ومتصلاً. وبقي الطوطم حيًّا في كرة القدم لأن اللعبة لم تُلغِ الجينات الثقافية العميقة التي رافقت الإنسان عبر تاريخه الديني والاجتماعي، بل أعادت تنظيمها ونقلها. فالأديان التي مرّ بها الإنسان لم تتبدد أو تختفِ، وإنما تحوّلت خطاطاتها الرمزية—خطاطات القتال، والتضحية، والانتماء، والبقاء—وانتقلت إلى مجالات أخرى، بعضها ما يزال داخل إطار التدين، وبعضها استقر في فضاءات حديثة كالرياضة، والفرجة الجماهيرية. لم يعد الصراع في كرة القدم يُمارَس بالدم، بل يُمثَّل بالأهداف؛ ولم يعد يُحسم بالسلاح، بل بالتكتيك والمهارات؛ ولم يعد الموت جسديًا، بل إقصاءً رمزيًا، بما في ذلك البطاقة الحمراء لمن لا يحترم قانون اللعبة، ومع هذا التحول، ظل الطوطم ضروريًا، بوصفه الوعاء الذي تُعاد فيه برمجة هذه الجينات الثقافية في شكل حديث. هو رمز للقتال المُنظَّم، وللمغامرة المحسوبة، وللاستمرار الجماعي رغم الهزيمة.كرة القدم ليست مجرد لعبة…إنها طقس حديث للانتماء.ذ. محمد معروف، جامعة شعيب الدكالي
-
آسفي والمدن المغربية المنسية: بين مفاهيم الإقصاء وعقاب السلطة
إن المفاهيم السوسيولوجية الكلاسيكية مثل (التهميش، الإقصاء، النبذ، الوصم، غياب العدالة المجالية والاجتماعية، وثنائية السرعة العالية/البطيئة) لا تسعفنا في فهم الوضع المعقد للمدن المغربية، لذلك لابد من البحث عن إطار تحليلي أعمق يتجاوز الوصف السوسيولوجي إلى التفسير السياسي والتاريخي لآليات التنمية الحضرية.غالبا ما يحاول المغاربة فهم الـتفرقة المجالية بين المدن، والمُتعمدة من طرف النظام السياسي، وفق نفس الثنائية القديمة: المغرب النافع والمغرب غير النافع، حيث هذا التقسيم يجعل الثروات الطبيعية مرافقة للتنمية، ويلخص الثورات الطبيعية في الفلاحة والأرض الخصبة والسهول والماء، لذلك تحظى مدن السواحل بتنمية أكبر. في حين أن الموارد المحلية مع النظرية الاقتصادية المعاصرة قد تغيرت. كما أن مدن مثل العاصمة ليس لها أي موارد طبيعية، ومدن أخرى تحتوي الفوسفاط والذهب تعاني التهميش. لذلك بدل الاكتفاء بوصف التهميش كظاهرة اجتماعية، يجب تحليلها كـنتيجة مُتعمّدة لسياسات الدولة المركزية. حيث المدن المغربية لا تعاني فقط من نقص في التوزيع العادل للثروة أو الخدمات، بل تعاني من اختلالات هيكلية ناتجة عن نموذج تنموي اعتمد على المركزية المفرطة، حيث تتركز قرارات الاستثمار والتنمية في العاصمة وبعض المدن القريبة منها، مما يحول المدن الأخرى إلى مجرد هوامش وظيفية. ويغيب دور الدولة الحديثة في محاربة الإقصاء وإدارة التنوع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، بل تسعى لزيادة الفوارق وتكريس الاقصاء وتعزيزه. كما يتم اعتماد الإدارة الأمنية للمجال، بحيث يتم تحويل التنمية الحضرية في بعض المناطق من مشروع اقتصادي-اجتماعي إلى أداة للتحكم السياسي والضبط الأمني، وأحيانا إعادة تقسيم الثروات بين النخب المحلية من أجل انتاج خريطة سياسية جديدة. لقد اعتمد النظام في فترات عديدة إعادة تقسيم المياه والأراضي بين القبائل والأعيان.لذلك يجب ربط التهميش الحضري بمحطات سياسية محددة، حيث مدن مغربية كثيرة تم تهميشها انتقاماً من سكانها. تحديداً في عهد الملك الحسن الثاني، حيث المحاسبة لم تقتصر على الأفراد والشخصيات التي قامت بالفعل، بل امتدت لتشمل "المجال" ككل.أنتجت السياسيات الممنهجة اتجاه اهداف التنمية مدناً منسية، فقدت دورها الاقتصادي أو السياسي وتم إزاحتها من الأجندة التنموية الوطنية. كانت بعض المدن التقليدية تعتبر نفسها أعرق من المدن الأخرى التي أحدثها المستعمر، ونجد مدن أسبق من الدولة الوطنية نفسها. ودائما ما يفتخ ساكنة أزمور أنهم أعرق من فاس المدينة العلمية، ويذكرون الرسالة المشهورة "من حاضرة أزمور إلى قرية فاس"، لكن أزمور تحولت هي الأخرى إلى قرية، بينما فاس تعاني من غياب التنمية. يتم معاقبة مدينة آسفي ومراكش أنهما أساءتا استقبال الملك الحسن الثاني في إحدى الزيارات. ومدن عانت من غياب التنمية لأنها كانت محط نزاعات اقليمية أو وجدت على الحدود الشرقية. بينما مدن جديدة تظهر كشواهد على المراكز التنموية المرتبطة بالنفوذ السياسي والشخصي، فمدينة سطات ارتبطت بجهود البناء التي قام بها وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري في عهد الحسن الثاني، لأنه ابن المدينة وينتمي إليها. أيضاً تنهض مدينة بن جرير اليوم في ظل مشاريع البناء التي يشرف عليها مستشار الملك محمد السادس علي الهمة، لأنه ابن المنطقة. في المقابل، شهدت مدينة الجديدة بدورها نمواً ملحوظا في فترة حكم عائلة أرسلان التي تنتمي للمنطقة، في حين عرفت ركودا وفسادا كبيرين في العقدين الأخيرين. عرفت بعض المدن انتفاضات كثيرة مثل فاس ومراكش، والدار البيضاء، وبعض مدن الشمال والشرق، التي شهدت احتجاجات قوية (خاصة انتفاضات 1981 و1984)، عوقبت بـتجميد التنمية الحضرية المُعمّقة أو بـتوجيه الاستثمار نحو مدن "موالية" أو مراكز اقتصادية جديدة، مما أدى إلى شيخوخة بنيتها التحتية وتدهور خدماتها. حيث يتم توظيف التنمية بشكل سياسي، باستخدام المشاريع الكبرى كأداة للمكافأة والولاء، حيث تعطى إشارة للمعارضين أنه كي يحظو ببعض التنمية والموارد عليهم أن يقدموا الولاء المطلق.إن فهم وضع المدن المغربية يتطلب تحليلاً متكاملاً يمزج بين التحليل السوسيولوجي لتوزيع الثروة والفرص والتحليل السياسي لكيفية استخدام السلطة للمجال كأداة للسيطرة والمحاسبة التاريخية، هذا الإطار يسمح برؤية التهميش ليس كـ"فشل في التنمية"، بل كـ"نجاح في سياسة الضبط السياسي عبر المجال".وفي الأخير نطرح إشكالية تواصل هذا الإرث السلطوي، حول مدى استمرار إرث "العقاب" في السياسات التنموية الحالية، حتى مع التحولات الدستورية والجهوية "الموسعة". هل تحول العقاب الصريح والمشخصن إلى إهمال بيروقراطي مُقنّع، ينتج نفس النتائج في غياب عدالة مجالية، لكن بآليات أكثر تعقيداً؟ أم هو تقليد ممنهج داخل دوائر الحكم أنتج نفس المعايير السابقة؟ أم هي استثمارات النخب البرجوازية القريبة من دواليب الحكم، والتي تفضل الاستفادة من القرب المجالي للسلطة للحصول على امتيازات سياسية واقتصادية؟
-
من المعبد إلى المدرّج: كرة القدم بوصفها دينا ضمنيا
لم تعد كرة القدم مجرد لعبة أو شكل من أشكال الترفيه الجماهيري، بل تحوّلت في المجتمعات المعاصرة إلى نظام ثقافي بمعان واستعارات تحيا بها الجماهير، إذ تؤدي وظائف تضاهي ما تؤديه الأديان التقليدية، وتمنح معاني الانتماء، والطقوس، والتضحية من أجل الفريق، بل حتى الشجار والقتال من أجل القميص يصبح راية يؤمن بها المشجع. وتحدد كرة القدم جزءا من هوية الفرد الاجتماعية، إذ يتم إنتاج سرديات مُؤسِّسة، وإضفاء قداسة رمزية على الفريق ولاعبيه الأساطير. وفي هذا السياق، يمكن فهم كرة القدم بوصفها الدين الضمني (Implicit Religion)، الذي تعتنقه الجماهير، أي ذلك الشكل من الالتزام والمعنى الذي يعمل خارج المؤسسات الدينية، لكنه يؤدي وظائف دينية واضحة في حياة الأفراد والجماعات. فهو التزام وإيمان بدون عقيدة، إذ تُولِّد كرة القدم درجة التزام عالية، تصل حد التعصب. فمشجعو الفرق لا “يتابعون” فرقهم فحسب، بل ينتمون إلى هذه الفرق، ويقدمون لها فروض الولاء لأمد طويل، وتُولِّد لديهم طاقة عاطفية، وغالبًا ما يُورَّث هذا الانتماء عبر الأجيال، ويُعد تغيير الفريق خيانة رمزية، تمامًا كما يُنظر إلى تغيير العقيدة في السياقات الدينية. غير أن هذا الالتزام لا يقوم على نص مقدس، أو أحاديث، أو كتاب يؤسس لهذا الدين، بل يعتمد على ذاكرة جماعية من الانتصارات والهزائم، ومن الفرح والمعاناة المشتركة.هذا الدين الضمني له مرافقه وبيوته، حيث تؤدى طقوسه، ويعيش المشجع خمرة الإيمان، شأنه شأن المتصوف الذي يعيش "العمارة الصوفية"، ويتحول الملعب من مجرد بنية إسمنتية إلى فضاء طقسي بامتياز. فالدخول إليه في يوم المباراة يشبه الدخول إلى مكان شعائري منظم بدقة. فهناك أوقات محددة ومواعيد للمباريات، وهناك لباس خاص (أقمصة، وألوان، وأوشحة)، وتصدح الجماهير في تناغم بأناشيد جماعية، وهتافات، وتعيش لحظات صمت وانفجار، وبكاء ونشوة، ودعاء، وصلوات، وسجود وغيره من الطقوس، فتنتقل خطاطات الممارسات الدينية التقليدية الى المدرج والبساط الأخضر. وفي هذه الحالات، يتجلى ما سماه عالم الاجتماع إميل دوركايم "بالفيض الجماعي"، وهو شعور يتجاوز الفرد عند ذوبانه في الجماعة، حيث تختفي الذات الفردية داخل الذات الجماعية.تنتج كرة القدم سرديات كبرى تشبه الحكايات الدينية، فهناك فريق مظلوم ، قد يتبنى خطاب المظلومية، كما وقع في حالة الجزائر عند إقصائها من العبور لمونديال قطر، إذ حملت المسؤولية للحَكَم، وهناك فرق تٌهزَم، لكنها تنهض من الهزيمة، وتتحول الخسارة إلى أسطورة مٌؤسِّسة. وهناك لاعب يُقدَّس، وآخر يُدان، ويعاش الموسم الكروي كرحلة خلاص أو سقوط حَلَقي. تلك هي السرديات التي تمنح الحياة اليومية معنى إضافيًا، وتٌحوِّل الزمن الرياضي إلى زمن أخلاقي، يتضمن الصبر، والأمل، والإيمان، والمجازفة، والمقامرة، والخيبة، ثم عودة الإيمان من جديد.في هذا الإطار، تبرز التميمة – مثل تميمة كأس إفريقيا للأمم "أسد"2025 --بوصفها تجسيدًا بصريًا للمقدّس الرياضي. فالتميمة تختزل الأمة في شخصية واحدة، وتُبسّط الهوية دون إفراغها من دلالتها. فتسمح التميمة بالتداول، واللعب، والتملك الرمزي، فالأسد هنا ليس مجرد حيوان كرتوني، بل هو شخصنة للانتماء الجماعي. يتمثل الأسد في الصورة لاعبا يافعا، قويا، لكنه ودود، وقريب من الأطفال، مشبع بدلالة السيادة والقيادة. إنها صيغة حديثة للرمز المقدّس القابل للاستهلاك، فلا ننسى أن رمز الأسد هو رمز الوحدة بالمغرب، والدرع الملكي في شعار المملكة يدعمه أسدان اطلسيان. تتحول كرة القدم في البطولات الكبرى إلى دين مدني، حيث يظهر العلم، والنشيد الوطني، والمنتخب، والنجوم، والتميمة، وكلها عناصر تشكّل طقسًا وطنيًا دوريًا. وفي هذا السياق، لا تُمارَس الوطنية عبر الخطب أو الشعارات السياسية، بل عبر اللعب، والمشاهدة، والتشجيع، والمشاركة الرمزية، وهنا تتجلى قوة كرة القدم الحقيقية، فهي تُنتج شعورًا بالوحدة الاجتماعية دون أي إكراه، وتبني هوية جماعية مشتركة تذوب فيها الفوارق الاجتماعية وتصبح غير مرئية، من دون حاجة إلى خطاب أيديولوجي مباشر. يهتف الغني والفقير معًا في المدرّجات، باسم الفريق وباسم الوطن.ولتقديم فهم نظري أعمق لهذه الظاهرة، يمكن الاستعانة بمفهوم "الدين الضمني"، كما طوّره عالم الاجتماع البريطاني إدوارد بايلي. فبايلي لا يعرّف الدين انطلاقًا من العقيدة أو المؤسسة، بل من خلال درجة الالتزام، والممارسة الطقسية، ومركزية المعنى في الحياة اليومية. وبهذا المعنى، تؤدي كرة القدم الوظائف نفسها التي يؤديها الدين، حيث تخلق انتماءً طويل الأمد، وتنظّم الزمن عبر طقوس متكررة، وتمنح الأفراد إحساسًا بالهوية والمعنى يتجاوز حياتهم الفردية. إنها دين بلا لاهوت، لكنها مشبعة بالرموز، والعاطفة، والقداسة الجماعية. ورغم كل ذلك، فلا يمكن اعتبار كرة القدم عقيدة بالمعنى الدقيق للكلمة. فالعقيدة تقوم على نسق من المعتقدات المُلزِمة حول الحقيقة، والوجود، والخلاص، وما يجب الإيمان به أو رفضه، لكن كرة القدم لا تقدّم تفسيرًا كونيًا للعالم، ولا إجابات عن أصل الوجود أو غايته، ولا تصورًا ميتافيزيقيًا للخير والشر. كما أن العقيدة تفترض نصًا مرجعيًا أو سلطة معيارية، بينما تفتقر كرة القدم إلى نص مؤسس أو إيمان مُلزِم، على الرغم من وجود قواعد اللعبة التنظيمية، وهي قابلة للتغيير دون أن يهتز "الإيمان" باللعبة. إن الانتماء العقائدي يكون شاملًا للحياة كلها، في حين أن انتماء كرة القدم جزئي ومجالي، وحتى إن كان قويًا عاطفيًا. لهذا تصنف كدين ضمني لا عقيدة. وكرة القدم لا تنتج إيمانا دوغمائيًا، لكنها تُنتج التزامًا، وطقوسًا، ومعنى جماعيًا، وأحيانا تعصبا مرفقا بإساءات عنصرية، كما هو الشأن مع لاعب مدريد فينيسيوس. إنها ليست عقيدة تُعتنق… بل تجربة تُعاش.يتعزز هذا البعد الضمني لكرة القدم اليوم عبر المنصات الرقمية مثل يوتيوب وتيك توك، حيث تعاد صياغة اللعبة في مقاطع قصيرة تمزج بين المهارة، والفكاهة، والموسيقى. وهذه المقاطع لا تكتفي بعرض الأداء الرياضي، بل تحوّله إلى طقس يومي خفيف قابل للمشاركة والتكرار، حيث يربط الجماهير باللاعبين عاطفيًا خارج زمن المباراة الرسمي، ويخلق الضحكة، والنكتة، وتصبح الحركة المتقنة أداة لإعادة إنتاج الانتماء، ولتطبيع القداسة الرمزية في شكل مرح متاح للجميع. في عالم تتلاشى فيه معاني الإيمان المؤسساتي، أو لا تستطيع بناء لحمة اجتماعية، قد تتقدم كرة القدم لتملأ فراغ هذه المعاني الثقافية…لا باعتبارها دينًا بالمعنى التقليدي، بل بوصفها دينًا ضمنيًا، وطقسًا بلا معبد، وقداسة بلا إله، وإيمانًا جماعيًا يُمارَس عبر اللعب، والصورة، والشعور بالانتماء.
-
هل تستطيع الجزائر تفكيك سردية العداء لبناء وطنها المُتخيَّل؟ .
تتشكل الأوطان، كما يوضح ذلك بنديكت أندرسون، عبر سرديات متخيّلة تُبنى من خلال الخطابات والممارسات الدالة، والرموز الثقافية، لا عبر الجغرافيا الفيزيقية فحسب، فالإحساس بالانتماء، واللحمة الوطنية، وحدود "نحن" و"هم"، كلها تتضمن خطاطات مستمرة تعيد رسم الصور الذهنية للذات الوطنية، وتأويلها. لا ترث الدولة هوية جاهزة، بل تصنعها عبر الإعلام، والتعليم، والذاكرة الجماعية، والثقافة، وبناء التاريخ والزمن والفضاء المشترك، وصناعة العدو والصديق. لذلك، فإن الخطاب السياسي ليس مجرد أداة تواصل، بل هو بنية تأسيسية تُعيد تشكيل الوعي الوطني، وتحدد من يدخل في الجماعة ومن يُستبعد منها. وفي السياق الجزائري، تشكل سردية العداء للمغرب أحد أهم مكوّنات هذا "الوطن المتخيَّل"، حيث تصبح شيطنة الجار جزءًا من هندسة الهوية ومن آليات إنتاج التماسك الداخلي. والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو: هل يمكن للجزائر تفكيك هذه السردية وبناء وطن متخيّل جديد لا يقوم على العداء، بل على مشروع إيجابي تنموي جامع؟يشكّل قرار مجلس الأمن 2797 (2025) لحظة سياسية مفصلية في مسار النزاع حول ملف الصحراء. فإلى جانب تأكيده، مرة أخرى، أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الواقعي القابل للتطبيق، يكشف القرار عن أزمة أعمق تعيشها الجزائر: كيف يمكن لدولة رسخت جزءًا كبيرًا من سرديتها الوطنية على شيطنة المغرب، أن تدخل اليوم في مسار تهدئة أو حوار؟ وهل تمتلك أصلًا القدرة على بناء مشروع وطني مستقل، لا يستمد تماسكه من وجود "عدو خارجي"؟ لقد اشتغلت الجزائر، طوال عقود، وفق ما يصفه علماء تحليل الخطاب بـ المربّع الأيديولوجي ( Teun A. van Dijk’s ideological squaring): تمجيد "نحن"—أهل الشرعية الثورية—وإخفاء عيوبها، وإبراز “هم” — أي المغرب — كخطر دائم، مع طمس أي فضائل محتملة له. هذه الآلية التي تنتج هوية سلبية تقوم على العدو أكثر مما تقوم على الذات، ليست حكرًا على الجزائر فقط؛ فقد تجلت في السردية الإيرانية تجاه الغرب، وفي خطاب كوريا الشمالية تجاه الولايات المتحدة، بل وفي تجارب عربية سابقة وظّفت فيها السلطة صورة "العدو الخارجي" لصناعة تماسك داخلي وتبرير الاستنفار السياسي.وتبدو ملامح المربّع الإيديولوجي واضحة في الخطاب السياسي والعسكري والإعلامي الجزائري خلال السنوات الأخيرة. فحين يصرّح رئيس أركان الجيش، السعيد شنقريحة، بأن " المغرب هو العدو الكلاسيكي للجزائر "، فإنه لا يقدّم توصيفًا عابرًا، بل يعيد إنتاج سردية مُؤسسِّة تجعل من المغرب عنصرًا ثابتًا في تحديد هوية الدولة. وفي الإعلام الرسمي، تتردّد عبارات من قبيل "الكيان الصهيوني الجديد"، و"النظام المخزني العدواني/ التوسعي"، و"المخزن الإرهابي"، في سياق يرمي إلى تضخيم تهديد الآخر وإخفاء أي صورة إيجابية له. وحتى على المستوى الدبلوماسي، تصرّ الجزائر في محافل متعددة على توصيف المغرب بأنه مصدر عدم الاستقرار في شمال إفريقيا، في حين تُهمل دور الرباط في مكافحة الإرهاب ودعم الأمن الإقليمي. إن هذا النمط الخطابي يؤكد جميع آليات المربّع الإيديولوجي: تمجيد الذات، وإخفاء تناقضاتها مع تضخيم مساوئ الآخر، ومحْو فضائله، مما يجعل أي تقارب مع المغرب يبدو وكأنه تهديدًا لثبات السردية الرسمية، أكثر مما يبدو خطوة نحو السلام. إذا كانت الوحدة الجزائرية — في جزء منها — مبنية على "استقطاب أيديولوجي"، يجعل من المغرب محورًا لتعريف الذات، فكيف يمكن تعديل هذا النموذج دون أن تتفكك بنيته الداخلية؟ وهل تستطيع السلطة في الجزائر الانتقال من خطاب العداء إلى خطاب التنمية والحداثة، أو أن هذا التحول يهدد توازنات داخلية حساسة، لا ترغب السلطة في الاقتراب منها، بل تعمل على تقديسها عبر تبني مقاربات تُغلِّفٌها بالشرعية الحقوقية والأخلاقية، والتاريخية والرمزية، فتُقحِمها في دائرة الهوية والعقيدة الوطنية؟تواجه الجزائر معضلة أعمق تتعلق بقدرتها الفعلية على الدخول في مشروع تنموي حديث. فالبلاد تفتقر — بنيويًا — إلى البنية التحتية الملائمة، وإلى الكفاءات البشرية المؤهلة، وإلى نماذج الحوكمة التي تسمح بإطلاق مشاريع استراتيجية كبرى. وقد أدّى اعتماد النظام لعقود على منطق "العسكرة الشاملة" — حيث تُستعمل أدوات الدولة أساسًا للتعبئة والسيطرة لا للتخطيط والإنتاج — إلى تعطيل بناء مؤسسات قادرة على التفكير في المستقبل أو إدارة التحولات الاقتصادية. لهذا، يجد النظام نفسه أسير خطاب العداء، لأنه يعوض عجزه عن تقديم بدائل اقتصادية وتنموية، بخلق خصومة مزمنة مع الجار الغربي. إن ضعف جاهزية الدولة للانتقال نحو نموذج حداثي، يفسر أيضًا خوفها من أي تقارب مع المغرب، لأن مثل هذا التقارب سيفضح الفارق الهائل في القدرات والمؤسسات والخيارات الاستراتيجية بين البلدين.إن السياق الدولي اليوم، لم يعد يحتمل نزاعات مُفتعلة تستعملها الأنظمة كأدوات لإنتاج الشرعية، حيث تدفع القوى الكبرى، والمؤسسات الأممية، والمناخ الجيوسياسي الإقليمي، نحو حلول مستقرة، وترى أن استمرار الأزمة يُضعف شمال إفريقيا اقتصاديًا وأمنيًا. وهنا يفرض الواقع أسئلته: إلى أي مدى تستطيع الجزائر مقاومة هذا الضغط؟ وما التكلفة السياسية والاقتصادية التي ستتحملها للاستمرار في سياسة "المواجهة الرمزية" مع المغرب؟يرسل المغرب من جهته إشارات هادئة ومتكررة نحو التهدئة، متمسكًا بالحكم الذاتي بوصفه خيارا استراتيجيا وحيدا، ومستعدًا — نظريًا — لإعادة بناء علاقات مغاربية جديدة. لكن هل تجد هذه الإشارات من يتلقاها في الجزائر؟ وهل يمكن لبلد بُني جزء من وعيه السياسي على وجود "عدو ضروري" أن يتنازل عن هذا البناء دون زلزال اجتماعي وسياسي داخلي؟ إن مستقبل القرار 2797 لا يرتبط بموقف المغرب — الذي يمتلك رؤية واضحة — بقدر ما يرتبط بقدرة الجزائر على تفكيك المربّع الأيديولوجي الذي شكّل خطابها ناحية المغرب لسنوات. فإذا ظلت الهوية السياسية الجزائرية سندًا لمنطق "شيطنة الآخر"، فسيكون من الصعب تصور أي مسار تفاوضي جاد. أما إذا استطاعت الجزائر إعادة تعريف ذاتها عبر مصلحة وطنية مستقلة، لا عبر العداء، فقد يكون القرار بداية لمرحلة جديدة تنتهي فيها آخر بؤر التوتر في شمال إفريقيا. ويظل السؤال الذي لا مفر منه مطروحا: هل تستطيع الجزائر تجاوز خطاب العداء الذي بنَت عليه تماسكها الداخلي؟ وأن القرار الأممي سيصطدم، مرة أخرى، بجدار نظام يحتاج إلى "عدو خارجي" أكثر مما يحتاج إلى السلام؟ هل تستطيع الجزائر تفكيك سردية العداء بعد قرار مجلس الأمن؟.ذ. محمد معروف، جامعة شعيب الدكالي
-
هــنــيــئــــا لــــــك يـــا بــــــــلادي.. بقلم الأستاذ الدكتور الحاج الكوري
بمناسبة الذكرى الخمسينية للمسيرة الخضراء المظفرة، وبعد اعتراف مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 بمغربية الصحراء، والخطاب السامي لجلالة الملك محمد السادس نصره الله الموجه إلى شعبه الوفي عقب صدور القرار الأممي المذكور، هذا القرار الذي أكد أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب منذ سنة 2007 هي الإطار الوحيد والأمثل والواقعي لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.لقد عمت الفرحة قلوب المغاربة من طنجة إلى الكويرة، في لحظة تاريخية تفيض بالاعتزاز الوطني، وأحسست، بفرحة غير مسبوقة، فـ«حب الأوطان من الإيمان». وبالفعل فقد خرج المواطنون بعد الخطاب الملكي السامي إلى الشوارع والساحات العمومية في مختلف المدن، حاملين الرايات الوطنية للتعبير عن فرحتهم، وهم يرددون النشيد الوطني ونشيد المسيرة الخضراء، في مشهد جسد أسمى معاني الوحدة والوفاء للوطن وللعرش العلوي المجيد.إن الفضل في تحقيق هذا الانتصار الدبلوماسي العظيم يعود بالدرجة الأولى إلى جهود وتضحيات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لمدة تزيد عن ربع قرن من العمل الجاد والمتواصل، وذلك على كل المستويات سواء على الصعيد الدولي أو الجهوي، وسواء في المجال الدبلوماسي او في المجال الاقتصادي والتنموي، لتكريس سيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية.وبهذه المناسبة المجيدة، نتقدم بأسمى آيات التقدير والتهنئة إلى جلالة الملك على كل هذه التضحيات والانجازات، سائلين الله العلي القدير أن يحفظه، ويبارك في عمره، وأن يوفقه لمزيد من النصر والعطاء.كما نوجه تحية إجلال وإكبار إلى كل المؤسسات الوطنية التمثيلية والتنفيذية، وفي مقدمتها القوات المسلحة الملكية وقوات الأمن الوطني، لما قدمته من تضحيات جسام طيلة مدة 50 سنة، منذ سنة 1975 إلى اليوم، في سبيل حماية أمن الوطن واستقراره ووحدته الترابية، دون كلل ولا ملل.فـهنيئا لك يا بلادي بهذا النصر والإنجاز الدبلوماسي الكبير، وهنيئا لك بما تحقق من إنجازات تنموية رائدة وصلت الى جيل جديد وصاعد من برامج التنمية الترابية والمجالية المندمجة، التي تجسد الرؤية الملكية الحكيمة لمغرب متجدد، قوي، ومعتز بهويته ووحدته.إمضاء: الأستاذ الدكتور الحاج الكوري جامعة محمد الخامس كلية الحقوق اكدال الرباط
-
الاستاذ محمد معروف يكتب ✍️| 31 أكتوبر.. نهاية الاستفتاء في الخطاب الأممي
يقدم هذا المقال تحليلا في لما يتعلق بالاستفتاء في تقرير مجلس الأمن رقم SC/16208 الصادر في 31 أكتوبر 2025 ، الذي يلخص ما جرى في الاجتماع، حيث تم تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) لعام إضافي حتى 31 أكتوبر 2026. وكما هو الشأن في التقارير السابقة، يواصل الخطاب الأممي استخدام لغةٍ دقيقةٍ ومحسوبة، تحافظ على الحياد السياسي، لكنها تُنتج حيادًا لغويًا يعيد تعريف الصراع ويُعيد بناء الزمن السياسي حوله. وترد في تقرير الأمين العام المشار إليه، جملة تبدو تقنية في ظاهرها، لكنها تضمر معاني سياسية محددة، إذ يقول البيان:"بينما لم يُجرَ الاستفتاء قطّ، واصلت بعثة المينورسو أداء المهام الموكلة إليها من قبل مجلس الأمن."“While the referendum has never taken place, MINURSO has continued to perform the tasks entrusted to it by the Council.”هذه الجملة القصيرة تختزن تحوّلاً في الخطاب الأممي من الحديث عن "استفتاء مؤجَّل"، (not yet) إلى الاعتراف الضمني "باستفتاء منتهي الصلاحية". فالصيغة المستخدمة، "لم يُجرَ الاستفتاء قطّ" (Never)، لا تعبّر عن تأجيل، بل عن نفيٍ مطلق يغلق أفق المستقبل. ولو استُعملت عبارة "لم يُجرَ بعد"، لأوحَت بوجود أمل في التنفيذ اللاحق، غير أن "قطّ" تحسم المسألة لغويًا: فالحدث لم يقع ولن يُتوقّع وقوعه.- حيادٌ نحويّ ينتج حيادًا سياسيًايُلاحظ أن الجملة تخلو من أي فاعل مسؤول (agency) عن غياب الاستفتاء؛ فلا يُذكر المغرب، ولا جبهة البوليساريو، ولا الأمم المتحدة نفسها. هذا الغياب المقصود للفاعل يحوّل “اللاحدث” إلى واقعة بدون مسؤول، ويخلق انطباعًا بأن الجمود نتيجة تلقائية، ويبهم المسؤولية، إذ تعتّم اللغة الدبلوماسية الصراع السياسي. إنها لغة تُخفي التوتر خلف البنية النحوية، وتحوّل التعطّل إلى حالةٍ إدارية مستقرّة.- بين النفي والاستمرارية في الزمنيوازن النص بين ما لم يتحقق، وهو والاستفتاء، وما يستمر في التحقق، وهو عمل البعثة. فبعد النفي يأتي الفعل الإيجابي: " واصلت بعثة المينورسو أداء مهامها"؛ وبهذا، يتحول استمرار البعثة إلى إطار لغوي لتبرير غياب التغيير؛ إذ يغدو الأداء الإداري نفسه دليلاً على النجاح المؤسسي، حتى وإن غاب الهدف المؤسس.ومن المهم أيضًا الانتباه إلى البنية الزمنية في الجملة الإنجليزية الأصلية، فاستخدام الزمن الحاضر التام (present perfect) ، لا يصف حدثًا ماضيًا فقط، بل يمتدّ زمن النفي من الماضي حتى اللحظة الراهنة، أي إنّ غياب الاستفتاء ما يزال قائمًا ومستمراً. يمنح هذا الاختيار الزمني النفي طابعًا دائماً ومتواصلاً، ولا يشير إلى حدث انتهى؛ بل إلى استمرارية الغياب. وبذلك لا تُقدَّم الجملة بوصفها توثيقا لحقيقة تاريخية، بل كحالة زمنية مفتوحة، تجعل غياب الاستفتاء جزءًا من الحاضر السياسي. أما في الترجمة العربية (لم يُجرَ الاستفتاء قطّ)، فإن دلالة الاستمرارية الزمنية تضيع جزئيًا، لأن الفعل الماضي المنفي يوحي بانتهاء الحدث، لا باستمرارية غيابه. لذلك يحمل النص الإنجليزي بعدًا إضافيًا يكرّس فكرة أن الاستفتاء ليس غائبًا في الماضي فقط، بل ما زال غيابه قائمًا في الحاضر — أي إن الزمن نفسه أصبح أداة لترسيخ الجمود السياسي.- المينورسو: الاسم الذي تجاوز وظيفتهمن خلال هذه الصياغة، تبدو بعثة المينورسو بوصفها كيانٍا يتكيّف مع الزمن، أكثر مما يسعى لتغييره. فاسمها الكامل — بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية — أصبح تسمية رمزية لوجودٍ إداري طويل الأمد، لا أداة لتحقيق هدف محدّد. لم يُنظَّم الاستفتاء، لكن البعثة تستمر، ويُجدّد تفويضها سنويًا، وتتحوّل مهامها وفق ما تراه قرارات مجلس الأمن مناسبًا.- الحياد اللغوي بوصفه إدارة للزمنفي هذا البيان، يتحدث مجلس الأمن عن "دعم خيار الحكم الذاتي المغربي باعتباره خطة واقعية وعملية"، دون أي إشارة إلى الاستفتاء بعبارة صريحة. واللغة هنا تحافظ على الإطار القانوني القديم، لكنها تفعّل مفردات جديدة مثل "الواقعية"، و"البراغماتية"، و"الاستقرار الإقليمي"، هذا التحوّل لا يُعبّر عن موقف سياسي مباشر، لكنه يشير إلى انتقال الخطاب الأممي من أفق الاستفتاء إلى أفق التسوية التدريجية، بحيث تُدار الأزمة بدل من حلّها. فمن خلال النفي المطلق " لم يُجرَ الاستفتاء قطّ"، وعبارات التمديد السنوي المتكرّرة في قرارات مجلس الأمن، يمكن رصد تشكّل ما يمكن تسميته "بزمن البعثة" — وهو زمن مفتوح لا يقيس التقدّم بالنتائج، بل بالاستمرارية ذاتها، فالخطاب لا يعلن لا فشلًا ولا نجاحًا، بل يرسّخ نظامًا لغويًا للجمود، يجعل البقاء شكلًا من أشكال الإنجاز.يبيّن تحليل هذه الجملة التي تكشف الصورة الذهنية التي تتبَنَّاها الأمم المتحدة عن الاستفتاء، أن استخدام النفي المطلق (NEVER)، وتجنّب تحديد الفاعل ليسا تفصيلين لغويين، بل آليتين لإدارة الصراع عبر اللغة. فبدلاً من إنهاء المهمة، تُعيد الأمم المتحدة صياغة وجودها من خلال الحياد اللغوي ذاته. يمكن قراءة استخدام النفي المطلق "لم يُجرَ الاستفتاء قط" في الخطاب الأممي، بوصفه تعبيرًا مضمرًا عن نهاية مرحلة، لا مجرد توصيفٍ زمني لحدثٍ غائب، فالكلمة لا تنفي وقوع الاستفتاء فحسب، بل تُعلن، بطريقة غير مباشرة، أن فكرة الاستفتاء نفسها أصبحت جزءًا من الماضي السياسي. إنها صياغة لغوية تُغلق الباب أمام احتمال وقوعه، وتؤطر الواقع ضمن منطقٍ جديدٍ أكثر واقعية وعملاً.من هذا المنظور، يمكن القول إن الاستفتاء تحوّل من وعدٍ مؤجَّل إلى حلمٍ منتهٍ، وأن الخطاب الأممي — من خلال هذا النفي — يُمهِّد لغويًا للتعامل مع الحل القائم على مشروع الحكم الذاتي، باعتباره الإطار العملي الوحيد الممكن ضمن السياق الدولي الحالي. فاللغة هنا لا تُعلن التغيير صراحة، لكنها تُعبِّر عنه بصمتٍ نحويٍّ دقيق: حين يُقال (has never taken place)، فإن المعنى الأعمق هو أن الطريق قد اتّجه نهائيًا نحو خيارٍ آخر، وأن ما كان يُنتظر بالأمس، صار اليوم من الماضي.ذ. محمد معروف، جامعة شعيب الدكالي
-
الخطاب الأممي بين التوصيف والتمثيل: المغرب باعتباره سلطة أمر واقع، والبوليساريو بوصفه لسانا لسكان الصحراء
من خلال تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع في الصحراء (S/2025/612)، تظهر ملامح انحياز لغوي غير مباشر في الطريقة التي تُقدَّم بها الأطراف المتنازعة، حيث تكشف الاختيارات المعجمية عن بناءٍ سردي يرسّخ صورة معينة لكل طرف: فالمغرب قُدم سلطة "مديرة" للأرض، وجبهة البوليساريو كـ"ممثل" للشعب الصحراوي بأسره، بما يتجاوز إطارها القانوني كحركة "تمثل" عددا محددا من "اللاجئين"/ سكان المخيمات بتندوف، هذا إذا فرضنا جدلا أن الجبهة منتخبة بشكل ديمقراطي.- المغرب: فاعلٌ بلا صوت تمثيلييتحدث التقرير عن المغرب بلغة الدولة والمؤسسة: "قدمت المملكة المغربية تفاصيل عن مبادراتها التنموية غرب الجدار"... "أكد وزير الخارجية المغربي دعم الدول الكبرى لمقترح الحكم الذاتي"... وتُقدَّم أفعال المغرب بأفعال إجرائية محايدة: " قدمت – واصلت – استقبلت – أنجزت – استثمرت."لكن اللافت أن التقرير لا يربط هذه الأفعال بتمثيل السكان الصحراويين المقيمين تحت سيادته الفعلية، بل يُحيل عليهم بعبارات مبهمة مثل “سكان الجزء الغربي من الإقليم". هنا تُمارس إزاحة تمثيلية: فالمغرب يُعترف به كفاعل سياسي وإداري، لكنه لا يُقدَّم كصوتٍ للصحراويين أنفسهم، مما يخلق فراغاً سردياً بين الدولة والمجتمع.- البوليساريو: صوت الشعب في الخطاب الأمميفي المقابل، تُقدَّم جبهة البوليساريو في التقرير بصفتها الناطقة باسم "الشعب الصحراوي": "أكد الأمين العام لجبهة البوليساريو إصرار الشعب الصحراوي على التشبث بحقوقه وأرضه"..."رحبت البوليساريو بقرار المحكمة الأوروبية الذي أكد الوضع المنفصل للصحراء الغربية." تُستخدم هنا أفعال القول : أكد – أعلن – رحب – عبّر) لترسيخ صورة البوليساريو كممثلٍ سياسي ذي شرعية معنوية للشعب الصحراوي بأكمله، وليس لسكان المخيمات في تندوف فقط. وبذلك يتحول مصطلح "الشعب الصحراوي" إلى مرادف ضمني للبوليساريو في السردية الأممية، بينما يُحجب المغرب عن أي تمثيل رمزي موازٍ لسكان الأقاليم التي يديرها فعليا؛ غير أن هذا لا يُعدّ انحيازاً متعمداً من كاتب التقرير أو من الأمم المتحدة نفسها، بل هو نتيجة غياب التنبيه الدبلوماسي أو اللغوي من الجانب المغربي على ضرورة التمييز بين الصحراويين المقيمين في الأقاليم الجنوبية و"اللاجئين" في مخيمات تندوف. ففي ظل هذا الصمت، يستمر الخطاب الأممي في اعتماد صياغة تجعل التمثيل الشامل للشعب الصحراوي حكراً على البوليساريو، دون أن يجد هذا الافتراض ما يناقضه رسمياً في الخطاب المغربي.- انحياز لغوي مقنّعيبدو هذا التفاوت انعكاساً لما يسميه الباحثون في تحليل الخطاب بالتحيّز في التمثيل: representation bias))فمن خلال الحياد اللغوي الظاهري، يتم تثبيت توزيع غير متوازن للشرعية: ●المغرب: فاعل إداري وتنموي بلا صوت تمثيلي للسكان. ●البوليساريو : فاعل رمزي وتمثيلي يتحدث باسم "الشعب الصحراوي".وبينما تلتزم الأمم المتحدة رسمياً "بالحياد"، فإن هذا الحياد اللغوي ينتج تمثيلاً إيديولوجياً مزدوجاً: يشرعن الوجود المغربي كإدارة أمر واقع، ويكرّس البوليساريو كممثل معنوي لشعب الإقليم.وخلاصة القول، إن تقرير الأمم المتحدة لا ينتهك الحياد السياسي، لكنه يُعيد إنتاجه عبر الحياد اللغوي، أي إنه يبدو محايدًا سياسيًا، لكن اللغة التي يستخدمها سواء في السرد أم في الاقتباس، تكرّس هذا الحياد بشكل يُنتج تحيّزًا ضمنيًا أو تمثيلًا غير متوازن. فمن خلال الصياغة، لا يُذكر المغرب كممثلٍ للصحراويين في الأراضي التي يديرها، بينما تُمنح جبهة البوليساريو وضعاً تمثيلياً ضمنياً "لشعب الصحراء بأكمله". هذه الفجوة الخطابية ليست تفصيلاً لغوياً، بل تكشف عن دينامية رمزية تحافظ على الوضع القائم وتؤطر النقاش الدولي ضمن ثنائية : " المغرب كسلطة أمر واقع مقابل البوليساريو باعتباره صوت الشعب". ويظل السؤال المطروح: هل سيتمكن المغرب، في التقارير الأممية القادمة من كسر هذه الثنائية القائمة بين سلطة الأمر الواقع وصوت الشعب، واستعادة موقعه بوصفه فاعلا يمثل سكان الصحراء ضمن مشروع الحكم الذاتي والجهوية الموسعة، لا مجرد سلطة إدارة؟ذ. محمد معروف، جامعة شعيب الدكالي
-
جيل Z المغربي على ديسكورد: الزخم الرقمي الموهوم والتقاطعات الإيديولوجية المقنعة
في الشهرين الأخيرين، تحوّل تطبيق ديسكورد من منصة مخصصة للألعاب والدردشة بالمغرب إلى فضاء سياسي بديل لشباب جيل212 Z ، حيث شكل وجهة لتمرير رسائل مكتوبة ومصممة وصوتية معارضة للنظام، رغم أن الحركة بدأت بمطالب اجتماعية في البداية. لقد تم إنشاء شبه مجتمع شبكي متشابك بأعضاء يفوقون "مئتي ألف مشارك"، وذلك ليس قصد المناقشة وتبادل الآراء، ولكن قصد إعادة تشكيل أشكال التعبير والهوية والانتماء. إن المعطيات المتوفرة لدينا حول الصورة الرقمية التي يقدمها خادم جيل z لا تعكس واقعًا تفاعليًا حقيقيًا، كما أشرنا إلى ذلك في مقال سابق، تناول طبيعة الحضور الوهمي على المنصة، بل غالبًا ما تقوم على زخم عددي مصطنع، يخفي وراءه حسابات وهمية، وتوجيهًا أيديولوجيًا دقيقًا من قبل مشرفين يتحكمون في الخطاب ومسارات النقاش وإليكم أمثلة في الموضوع.- الزخم الرقمي الموهومتُظهر المعاينة الأولية لخادم Gen Z المغربية على ديسكورد تباينًا حادًا بين الأرقام المعلنة والنشاط الفعلي، ففي غرف مثل #general-chat، قد يتجاوز عدد المتصلين ثمانية آلاف مستخدم، إلا أن المتفاعلين فعليًا لا يتعدون العشرات، وتجد معظم الحسابات تحمل رمز حالة الخمول، أو عدم الإزعاج، بينما الرمز الأخضر الذي يدل على نشاط المستخدم يظل قليلا. وتكشف عيّنات من الحسابات التي تم فحصها، أن كثيرًا منها لم يشارك بأي رسالة منذ انضمامه، وبعضها أنشئ مؤخرًا، مما يثير تساؤلات حول صدق هذه الأعداد وما إذا كانت تمثّل جمهورًا حقيقيًا أم مجرد حضور مصطنع.- الحسابات الحديثة والهبوط العددي المفاجئظهرت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2025 موجة ضخمة من الحسابات الجديدة على خادم جيل زيد المغربي، إذ العديد من الحسابات غير المتفاعلة والمنتشرة في الغرف، يظهر إنشاؤها في هذين الشهرين، والظاهرة الأكثر دلالة حدثت أثناء استضافة شخصيات مثيرة للجدل مثل الصحفي توفيق بوعشرين. فقد لوحظ أنه عند انقطاع النيت لدى أحد المشرفين الأساسيين على الخادم، انخفض عدد الأعضاء فجأة من نحو عشرة آلاف إلى أربعة آلاف في غضون ثوان.هذا السلوك الرقمي يشي بوجود بوتات bots وحسابات وهمية (Sock Puppets) تستخدم لتضخيم عدد الحضور بشكل آلي، فهي حسابات تدار من مستخدم واحد أو أكثر عبر برامج أو متصفحات متعددة، لتوليد انطباع بالحشد الشعبي والتفاعل الجماهيري. و من الناحية التقنية، تسمح آلية التسجيل السهلة في ديسكورد بإنشاء حسابات متعددة عبر بريد إلكتروني فقط. باستخدام برامج VPN وأدوات إنشاء بريد وهمي، و يمكن لأي مستخدم أن يمتلك عشرات الحسابات النشطة في آن واحد، ويديرها عبر حاسوبه او غوغل، نظرا لغياب خاصية “ تبديل الحساب” في تطبيق الهاتف، وبهذه الطريقة يمكنه إدارة مئات الحسابات لخلق انطباع بزخم جماهيري مصطنع، وهي ممارسة مألوفة في “الغزوات الإلكترونية” التي تستخدمها الجماعات المتطرفة في حملاتها الرقمية المنسّقة.- دور المشرفين في توجيه النقاشيلعب المشرفون (Moderators) دورًا حاسمًا في توجيه طبيعة الحوار داخل غرف الدردشات، ففي إحدى الغرف، أرسل أحد الأعضاء نصًا دينيًا وعظيًا يتحدث عن زوال الدنيا، فقام مشرف يُلقب نفسه ب “ غريب جاء من بعيد”، بالرد على المنشور بأن هذا 》النص لا يحمل أي ترويجً ضد النظام- لا السياسي ولا الاجتماعي، بل هو كلام وعظي وديني من كتب التفسير وغايته تذكير الناس بحقيقة الدنيا وزوالها لا أكثر،《، ودعا إلى منع النقاش حوله بدعوى الحفاظ على وحدة المنصة، كما منع النقاش حول التفرقة بين الديني واللا ديني، معتبرا أن الأمر مجرد اختلاف في الآراء، ولا يجب أن يبعد الأعضاء عن مناقشة قضايا الاستبداد في الحكم. هذا الموقف يكشف عن تحكم رمزي في الخطاب: فالمشرفون لا يكتفون بضبط السلوك، بل يعيدون تعريف ما هو مسموح وما هو ممنوع، ويحوّلون المنصة من فضاء نقاش إلى أداة تعبئة ذات اتجاه واحد، وتنشر سردية معارضة لسياسات الدولة، تقصي الأصوات المخالفة. إنها حالة تعبئة رقمية وإعادة ترسيم للفضاء الرقمي (reterritorialization) حيث يُعاد توجيه الخطاب نحو أهداف سياسية محددة، وتُقمع الأصوات التي لا تتماشى مع السردية العامة.- البنية الأيديولوجية المزدوجةرغم السيطرة التنظيمية الواضحة، فإن الخطاب داخل بعض هذه الغرف ليس متجانسا، حيث توجد النكتة، والسب أحيانا، خصوصا في الغرف الصوتية التي لا تخضع لسلطة مشرفين في غالب الأوقات. كما يلاحظ من التصاميم الأخيرة التي ظهرت على المنصة، وهي تحمل صورة القبضة المغلقة أو الشعارات الاجتماعية ذات الطابع العمالي، أنها من شعارات التيارات اليسارية، وفي المقابل، يظهر أيضًا تيار إسلامي تعبوي على المنصة، يتناول مواضيع مرتبطة بالتحكم، ومعارضة للنظام السياسي، أو قضايا الحرية الإعلامية، والتعبئة السياسية. وبهذا المعنى، تُشكّل المنصة ملتقى أيديولوجيًا تتقاطع فيه الرموز اليسارية والإسلاموية في شكل تعبئة رقمية هجينة، تستغل الخطاب الشعبوي حول إنشاء الملاعب وقضايا الفساد، لتأطير الشباب ضد النظام السياسي القائم. - ديسكورد بوصفه فضاء تعبئة رقمية لجيل Z المغربيتكشف العديد من المعطيات التي جُمعت --ولا يتسع هذا المقال للتفصيل فيها-- أن ديسكورد أصبح أكثر من مجرد تطبيق دردشة، بل مختبراا اجتماعيا أيديولوجيا يحاول اعادة تشكيل الوعي الشبابي، لكن بسردية مؤطرة وحيدة معارضة للنظام السياسي داخل فضاء رقمي مغلق أشبه بغرف الصدى، لا يُسمع فيها سوى الأصوات المعارضة للنظام السياسي، فيما تواجه الآراء المخالفة أو المتحفظة باتهمات جاهزة مثل "الذباب" أو "الزلايجية"، وتنتهي عادة بالإقصاء أو الطرد من الخادم.إن الزخم العددي المصطنع، و الحسابات الوهمية، والتحكم في مسارات النقاش ليست مجرد ممارسات تقنية، بل تعتبر أدوات رمزية تهدف إلى إعادة إنتاج الحشد وصناعة صورة جماعية منسقة لجيل يبحث عن معنى وانتماء في فضاء رقمي متحوّل، لكن السؤال المطروح هو: هل يشكّل هذا النشاط على ديسكورد قوة فعلية قادرة على الانتقال من العالم الافتراضي إلى الواقع، أم أنه يظل ظاهرة صوتية داخل غرف الصدى echo chambers))؟ ما يظهر لنا جليا هو أن أفرادا من الجيل المغربي الجديد، خصوصا المؤطرين منهم، يحاولون إعادة كتابة لغتهم الاحتجاجية الخاصة عبر مثل هذه المنصات، وذلك من خلال مزيج من الرموز، والذكاء التقني، وهم مازالوا في طور البحث عن هوية سياسية معارضة وسط شبكة معقدة ، تتداخل فيها الرقابة الرسمية مع التحديات الإقليمية، في ظل تراجع التمثيلية الحزبية، وفراغ واضح في التأطير البيداغوجي والإعلامي—تحاول التيارات الإسلامية ملأه والاستثمار فيه—، إذ يُفترض أن يوجه هذا الجيل ويمنحه أدوات الفهم والمشاركة الواعية.ذ. محمد معروف، جامعة شعيب الدكالي
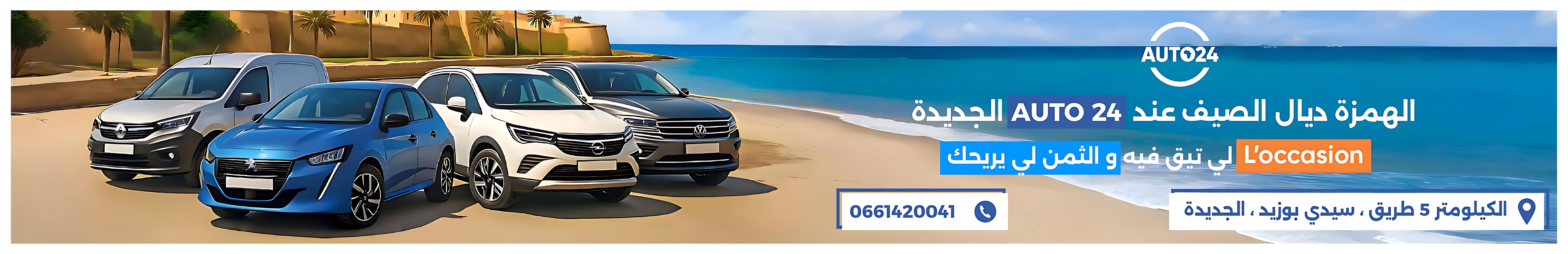
أعمدة الرأي